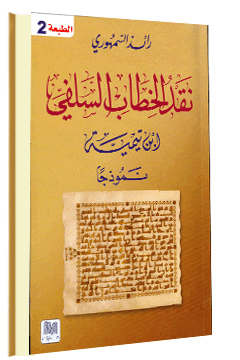أولًا: عرض الكتاب: كتاب هذا الشهر، هو واحد من الكتب التي تطعن في أصول الدِّين، وتهدِم ثوابته، وتنشر مذهب أهل البِدع والضَّلالات وخصوصًا المعتزلة الذين أُجمِع على ضلالهم ومخالفتهم لأصول الإسلام بأصولهم التي ابتدعوها، ولكنَّه يظهر في ثوب جديد؛ ثوب القِراءة المغايرة، والنقد العقليِّ، والعِلمي والحياديِّ! وقد دارت حول الكتاب نقاشات، وقامت بعرضه والثناء عليه للأسف (مجلة العصر الإلكترونية) بتاريخ 2011-3-1 م، واصفةً إيَّاه بأنَّه: (قراءة مغايرة لفكر وأطروحات ابن تيميَّة، تميل إلى تحميله عبئًا ليس بالقليل ممَّا وصلت إليه حالة الفِكر الإسلاميِّ من الانسداد والعجز عن إعادة بعث الحالة الحضاريَّة للأمَّة التي تخلَّفت؛ بسبب ما نخَر في فكرها من عقائد وجدليَّات فكرية، أصابتها بالشَّلل الحضاري أو التصادُم السلوكي مع (الآخر)؛ نتيجة ترسُّبات فكريَّة وعقديَّة تناقلتها الأجيال دون تمحيص ومراجعة)!
وسوف نعرض لهذا الكتاب، ونعقِّب على أهمِّ المآخذ عليه باختصار، ممَّا يبيِّن فداحة خطأ منهج المؤلِّف وأنَّ كتابه هذا ليس إلَّا مجرَّد ترديد لشُبه المتكلِّمين القُدماء، وخصوصًا المعتزلة، وثمَّت أمور أخرى مبنيَّة على الخطأ في فَهم منهج السَّلف أو (الخطاب السَّلفي) - على حدِّ تعبير المؤلِّف - وابن تيميَّة خُصوصًا، ممَّا تسبَّب في نسبة أُمور إليهم لم يقولوا بها بسبب الفَهم الخاطئ، وإلَّا فنقْد هذا الكتاب بالتفصيل، وتفنيد كلِّ الشُّبه التي فيه، يطول جدًّا، ويحتاج إلى كتاب كامل، وليس هذا محلَّه بطبيعة الحال.
وقد تألَّف هذا الكتاب - بعد تقديم د. رضوان السيد، ومقدِّمة المؤلِّف - من أربعة أقسام رئيسة، وتحت كلِّ قسم فصول، ومسائل متعدِّدة، وملخَّصها كالتالي:
القسم الأوَّل: موقف ابن تيميَّة من الآخر ، وقد جاء في خمسة فصول:
الفصل الأوَّل: ابن تيميَّة والآخَر غير المسلم، وتحدَّث فيه عن الكافر مَن هو عند ابن تيميَّة؟ وكيف نتعامل معه، وذكر أشياء ممَّا يَستنكره على شيخ الإسلام في تعامله مع الكفَّار، مثل قوله: غير المؤمن تجب عداوته وإن أحسن إليك، وقوله: وجوب إهانة غير المسلم وإهانة مقدَّساته، وأنَّ اليهود والنصارى ملعونون هم ودِينهم، وغير ذلك.
الفصل الثَّاني: ابن تيميَّة والآخر المسلم، وتحدَّث فيه عن ابن تيميَّة والآخَر المسلم بين النظريَّة والتطبيق، وأنَّه خالف القواعد النظريَّة التي أصَّلها عند التطبيق العملي - بحسب زعم المؤلِّف - في التعامل مع المسلم المخالف؛ مثل: الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة والاختلاف، وإنكاره على تكفير الطائفة لغيرها من المسلمين وأنَّ هذا بدعة منكَرة، وأنَّ المتأوِّل - مبتدعًا كان أو مرتكبًا للكبيرة - يُعذر بالجهل ولا يُكفر أو يفسق حتى تُقام عليه الحُجة، وكلامه عن التكفير والتفسيق بين المطلَق والمعيَّن.
الفصل الثَّالث: ابن تيميَّة والمرأة، وذكر فيه بعض العناوين التي تشرح تصوُّر ابن تيميَّة عن المرأة، سواء كانت مدحًا أو ذمًّا، مثل: المرأة كاللَّحم على وضم وهي أحوج إلى الرِّعاية والملاحظة من الصبي، والحديث عن تعليم المرأة، وأنَّ المرأة عورة وناقصة في مقابل كمال الرجُل، وتحدَّث كذلك عن الخلوة والاختلاط، وأنَّ المرأة أسيرة للزوج وهي كالمملوك له وعلى المملوك والعبد الخِدمة، وعن أوجه الشَّبه بين المرأة وبين العبد المملوك، وغير ذلك.
الفصل الرَّابع: ابن تيميَّة وغير العرب ، تحدَّث فيه عن رأي ابن تيميَّة أنَّ جِنس العرب أفضل الأمم وأذكى الأمم، وأنَّ خلاف هذا هو قول أهل البدع، منتقدًا ذلك الرأي.
الفصل الخامس: ابن تيميَّة وموقفه من علماء الطَّبيعة ، تحدَّث عن رأي ابن تيميَّة في تعلُّم هذه العلوم، وأنَّ اكتساب الفضائل بالاستغناء عن القراءة والكتابة أكملُ وأوفق لحال النبيِّ الأمِّي، وأنَّ علم الرياضيَّات والفَلَك كثيرُ التَّعب قليلُ الفائدة، وأنَّ إتقان الفلاسفة للعلوم الطبيعيَّة إنَّما هو لجهلهم بالله. وأنَّ الكيماويِّين يضاهئون خَلْق الله، وأنَّ الكيمياء لا تصحُّ في العقل ولا تجوز في الشرع، معلِّقًا على ذلك كله.
القِسم الثَّاني: قواعد منهج ابن تيميَّة في التوحيد ، وقد تناول فيه المؤلِّف جهود ابن تيميَّة في نقض مقدِّمات المتكلمين، والقواعد البديلة عنها؛ والتي عدَّ منها ثلاث قواعد:
القاعدة الأولى: أنَّ الله تعالى يُعرف ضرورةً بالفِطرة، وأنَّ معرفة الله أوضح من كون الواحد نِصفَ الاثنين، وتحدَّث عن الفِطرة واختلاف تفسيراتها واضطراب ابن تيميَّة فيها - بحسب رأيه.
القاعدة الثانية: وجوب الأخذ بظاهر النصِّ دون تأويل، ذاكرًا معاني التأويل عند ابن تيميَّة، ومناقشًا لها.
القاعدة الثالثة: الاكتفاء بما في النصِّ القرآني من حُجج وأقيسة دون الخروج عنها، وفي ضِمنها الحديث عن طريقة تقرير القرآن لمسائل أصول الدين، وأنَّها تشمل:
أ- الدَّلالة على آيات الخَلق بعامَّة وخَلْق الإنسان بخاصَّة.
ب- الأدلَّة القرآنيَّة العقليَّة.
ج- الأمثلة والأقيسة القرآنية (وقياس الأَوْلى خصوصًا).
القِسم الثَّالث: القَدَر في فِكر ابن تيميَّة ، وتحدَّث فيه عن الأسباب وأفعال العباد، وهل الأسباب مؤثِّرة في المسبَّبات، وعن أفعال العباد بين التخيير والتسيير، وأقسام النَّاس تُجاه القَدَر وموقف ابن تيميَّة منها، وعن نظرية المكتوب، والعلم الأزلي، وعن ثِمار عقيدة العلم الأزليِّ كما يفهمها شيخ الإسلام، وقد نصر فيه أقوال المعتزلة في هذه المسائل، وانتقد شيخ الإسلام ابن تيميَّة ونسبه للجَبْر!
القِسم الرَّابع: هل العقل مقدَّم على النَّقل؟ وهو عبارة عن (قراءة نقديَّة في كتاب درء التعارُض)، واشتمل هذا القِسم على تمهيد وفصلين؛ تحدَّث المؤلِّف في التمهيد لهذا القسم عن المِفتاح الذي نَفهم به كتاب درء التعارض، وعن المخاطَبين بهذا الكتاب وأنواعهم، وعن مقصد ابن تيميَّة من كتابه (درء التعارض)، ثمَّ حدَّد محلَّ النِّزاع وأنَّه يدور حول (أصول الدِّين بين ظواهر الكتاب والسُّنة ومقدِّمات المتكلِّمين العقليَّة).
وأمَّا الفصل الأول: فكان للحديث عن وجوه الردِّ على المتكلِّمين عند ابن تيميَّة، فذكر الردَّ الإجمالي، ثم ذكر الأربعة وأربعين وجهًا التي ردَّ بها ابن تيميَّة على المتكلِّمين، معلِّقًا على كلِّ ذلك وناقضًا له.
والفصل الثَّاني والأخير: كان للحديث عن إستراتيجيَّات ابن تيميَّة في ردِّه على المتكلِّمين، وذَكَر المؤلِّف أنَّه يمكن حصرها في أربع: الحِجاج العقلي، والحِجاج اللُّغوي، وتشنيع حال الخَصم، والدَّعم والتَّعزيز، موجِّهًا النقد لذلك كلِّه.
ثانيًا: نقد الكتاب:
هذا الكتاب ومنهج المؤلِّف فيه عليه مؤاخذات كثيرة جدًّا، وحسبُنا في هذا النقد أن نُشير فقط إلى المآخذ الرئيسيَّة، التي يَنبني عليها الكتاب، مع غضِّ الطَّرف عن الجزئيَّات والأمور الفرعيَّة؛ ليتَّضح منهج المؤلِّف وطريقة فَهمه للأمور:
يقول المؤلِّف (ص: 29): (وحين أقول: الخطاب السَّلفي؛ فإنَّما أعني حزمة من المفاهيم والأدوات المستخَدمة في النظر إلى النصِّ الدِّيني وإلى الواقع يعبر عنها بخطاب لُغوي، أو بسلوكيات وردود أفعال وتعامل وطريقة في الحياة، تلك المجموعة من الأدوات والمفاهيم والإجراءات ينسبها أصحابها إلى (السَّلف)، فهو نقد لخطاب منتسِب للسَّلف، ولا أعني بهذا النقد بالضرورة السَّلف أنفسهم. على أنَّ مصطلح (السلف) لا يخلو من إشكال؛ ذاك أن لكلِّ طائفة من المسلمين (سلفًا) تنتمي إليه، وترى أنه (سلفها الصالح)، ولكلِّ طائفة رجالها وعلماؤها ومحدِّثوها، ومرويَّاتها ودواوينها، ومنهجها في القَبول والردِّ، وفي التصوُّر عن الإله والإنسان، والنظرة إلى الكون والحياة وسننهما. وكلٌّ يزعم أنَّه على الحقِّ، وأنَّه منتسِب للصحابة الكرام، فهم (أسلاف) إذن، وليسوا سلفًا واحدًا)! وقد كرَّر المؤلِّف هذا المعنى في مواطن عديدة من كتابه بأساليب مختلِفة، من ذلك: (ص: 65)، و(ص: 94)، و(ص: 97).
ومن ذلك قوله (ص: 89) - تعقيبًا على جواب لشيخ الإسلام ابن تيميَّة عندما سُئل عن بعض مَن يتستَّر بمذهب السَّلف وهو ليس سلفيًّا، فقال لمن سأله: (إن أردتَ بالتستُّر أنَّهم يجتنون به ويتَّقون به غيرهم، ويتظاهرون به حتَّى إذا خُوطب أحدهم قال: أنا على مذهب السَّلف، هذا الذي أراده والله أعلم. فيُقال له: لا عيب على مَن أظهر مذهب السَّلف، وانتسب إليه، واعتزى إليه، بل يجب قَبولُ ذلك منه بالاتفاق؛ فإنَّ مذهب السَّلف لا يكون إلَّا حقًّا)- فقال المؤلِّف: ((هذا، وقد خطر لي وأنا أنقل هذه القطعة من كلام ابن تيميَّة أن أتخيَّل قائلها عالِمًا اثني عشريًّا يُسأل عمَّن يتستر بمذهب (آل البيت)، ثم يجيب بهذا الجواب نفسه لكن يقول: فإنَّ مذهب آل البيت لا يكون إلَّا حقًّا.. إلخ، أو فلنتخيَّل أن قائلها إباضيٌّ مثلًا، فأجاب: فإنَّ مذهب أهل الاستقامة لا يكون إلَّا حقًّا... أو معتزلي يقول: فإنَّ مذهب أهل العدل والتوحيد لا يكون إلَّا حقًّا... إلخ، فإذا قرأ هذه القطعة أحد المخالفين، فكيف سيكون وقعها عليه؟!)).
التعقيب:
أولًا: ليس (الخِطاب السَّلفي)، أو المنهج السَّلفي تحديدًا حِزمة من المفاهيم والأدوات...إلخ كما ذكر المؤلِّف، بل هو منهجٌ شاملٌ متكامل في فَهم الإسلام وتطبيقه عقيدةً وفِقهًا، وأخلاقًا وتعاملًا، وهو ما كان عليه الصَّحابة الكِرام وتابعوهم بإحسان، وأتباعهم، وأئمَّة الدِّين في كلِّ عصر، ممَّن شُهِد له بالإمامة، وتلقَّى النَّاس كلامهم بالقَبول خلفًا عن سَلف، دون مَن رُمي ببدعة، أو شُهر بلقب غير مرضيٍّ كالخوارج والمعتزلة والجهميَّة وغيرهم، وهؤلاء هم السَّلف الصَّالح المعنيُّون؛ لأنَّ الله تعالى زكَّاهم ورضي عنهم، وذكر أنَّ مَن آمَن بمثل ما آمنوا به فقد اهتدى، وحذَّر من اتِّباع غير سبيلهم، وكذلك مدَحهم نبيُّنا صلَّى الله عليه وسلَّم، وأخْبَر أنَّهم خير النَّاس، وأمرَنا باتِّباع طريقتهم، والاهتداء بهديهم، والنُّصوصُ في ذلك كثيرة معلومة؛ فليس هو مُصطلحًا مشكَلًا ولا غامضًا؛ فإنَّه يتوجَّه أولًا إلى المتقدِّمين من الصَّحابة والتَّابعين وتابعيهم بإحسان، ثمَّ كلُّ مَن التزم بأصولهم وعقائدهم نُسِب إليهم، وإنْ لم يوجد في زَمانهم ولا قُطرهم، وكذلك مَن خالفهم فليس منهم، وإنْ عاش بين أظهرهم؛ فهو مصطلح واضح بيِّن، وعليه: فليس هو إذا مجرَّد ردود أفعال، أو إجراءات ينسبها أصحابها إلى السَّلف...إلخ. بل هو في حقيقته يمثِّل الإسلام المحض النقي الذي جاء به نبيُّنا صلَّى الله عليه وسلَّم، ولا يضرُّ ذلك خَطأ مَن انتسب إلى مذهب السَّلف، فالمنهج معصوم، وأتباعه ليسوا معصومين، وكل يُؤخَذ مِن قوله ويردُّ إلَّا المعصوم صلَّى الله عليه وسلَّم.
ثانيًا: زعْمه بأنَّ لكلِّ طائفة من المسلمين سلفًا...إلخ، وأنَّ الكلَّ يزعم أنَّه على الحقِّ، وأنَّه منتسب إلى الصَّحابة الكرام...إلخ، وعلى ذلك فهم (أسلاف) إذن وليست سلفية واحدة. فهذا مردود؛ إذ العبرة بالحقائق لا بمجرَّد الادِّعاء؛ فمَن خالف الكِتاب والسُّنة وخالَف طريقة الصَّحابة وأتْباعِهم بإحسان، وأئمَّةِ الدِّين، فليس مِن أتْباع السَّلف، وهذه دواوين العقائد والآثار والمصنَّفات المسنَدَة بالأسانيد الصِّحاح والحسان، فيها آراؤهم ومنهجهم بأدقِّ التَّفاصيل؛ فليس المعتزلة ولا الخوارج ولا الجهميَّة ولا الرَّوافض وأمثالهم من السَّلف قطعًا، ولا يُعتدُّ بهم في الإجماع، وليس لهم سندٌ ولا سلفٌ فيما هم عليه من الباطل، وإن انتَسبوا إليهم زُورًا وبهتانًا، أو تلبيسًا على الخلق لتمويه ما يأتون به من باطل، وإنْ زعموا أنَّ لهم سلفًا؛ فلا يُقبل مدَّعٍ بلا برهان، وكلٌّ يدَّعي وصلًا بليلى وليلى لا تقرُّ لهم بذاك!
ونسأل المؤلِّف: هل كان من الصَّحابة مَن ينتحل مذهب المعتزلَة أو مذهب الجهميَّة، أو مذهب الخوارج وأمثالهم؟ أم أنكر عليهم الصَّحابة بِدَعَهم، كما فعل ابن عبَّاس وابن عمر رضي الله عنهم؟! وهل للمعتزلة سلفٌ من الصَّحابَة الكرام؟!
وأيضًا على كلام المؤلِّف هذا، يكون كلُّ الخلق على الحقِّ؛ إذ لا أحدَ إلَّا ويزعُم أنَّه على الحقِّ، وأنَّ له سلفًا وسندًا على ما يقول، ولا يوجد مَن يصف نفْسَه بأنَّه على الباطل! فالشَّيطان الرَّجيم يقول: إنِّي أخاف الله، ويبرِّر عدم سجوده لآدَم بقوله: أنا خير منه! وفرعون الطاغية المفسِد يقول: وما أَهديكم إلَّا سبيل الرَّشاد.
وعليه؛ فليس في المصطلح إشكالٌ لمن فَهمه على وجهه، والحقُّ واحد لا يتجزَّأ، وبهذا يتَّضح معنى قول شيخ الإسلام ابن تيميَّة (فإنَّ مذهب السَّلف لا يكون إلَّا حقًّا) ويظهر صحَّته، ودقَّة فَهمِه رحمه الله تعالى، ويتبيَّن خطأ المؤلِّف السَّمهوري وقصور فَهمه، ولا يتوجَّه إليه ما طرحه من تساؤل، ويتبيَّن خطؤه فيه إذ يقول (ص: 29): (فلماذا كانوا هم الصالحين دون غيرهم؟ الإجابة: لأنَّ عقيدتهم صحيحة، وهكذا، فهم صالحون لأن عقيدتهم حسنة صحيحة، وعقائدهم حسنة مقبولة لأنهم صالحون! وهذا هو الدَّوْر الباطل منطقيًّا، فأنت تعرف بطلان الأقوال بتناقضها، والدور باطل لأنه يؤدي إلى التناقض...)، فليس فيه دَورٌ، وليسوا هم (أسلاف)، بل هم سلف واحد؛ مَن اتَّبع أصولهم وقواعدهم فهو سلفيٌّ، وهذا المنهج ليس حِكرًا على طائفة أو أشخاص معيَّنين، بل كلُّ مَن اتَّبعه وانتهجه وانتسب إليه فله نصيبٌ من هذا بقَدْر اتِّباعه لقواعده وأصوله، وبقدْر قُربه وبُعده، وإصابته وخَطئه .
وأمر آخَر هو من الأهميَّة بمكان بين يدي نقد هذا الكتاب، وهو: أنَّ الطَّعن على كثير ممَّا قرَّره ابن تيميَّة هو في حقيقة الأمْر طعن على سَلَف الأمَّة وعلمائها كلِّهم، إنْ لم نقُل على الكتاب والسُّنة أيضًا؛ إذ إنَّ ابن تيميَّة مقرِّر لأقوالهم، وتابع لمنهاجهم، ففَرْق بين ما قيل: إنَّ ابن تيميَّة تفرَّد به وشذَّ فيه عن مجموع الأمَّة - وهو نذر قليل؛ بغضِّ النَّظر عن كونه فعلًا شذَّ فيه أو لم يشذَّ، أو أصاب فيه أو أخطأ، أو أنَّ له عذرًا في ذلك أو لا، وبغضِّ النَّظر عن صحَّة الحُجج التي يقدِّمها على ما يقول أو عدم صحَّتها - فرْق بيْن هذه الأقوال والاعتراض عليها؛ فهذا الخطب فيه هيِّن، وما زال العلماء يردُّ بعضهم على بعض، وما زال النَّاس يخالف بعضهم بعضًا، وكل يُؤخذ من قوله ويُردُّ...إلخ. وأمَّا ما قرَّره من دَلالات الكِتاب والسُّنة وما اتَّفق عليه سَلف الأمَّة وأئمَّتها قبل ابن تيميَّة وبعده أيضًا، فهذا الطعن فيه لا شكَّ أنَّه طعن على الأمَّة كلِّها، وليس على ابن تيميَّة في حقيقة الأمر. وسيتَّضح هذا في النقطة التالية:
- ومن المؤاخذات على المؤلِّف: حديثُه عن الكافر في فِكر ابن تيميَّة وعن نظريتِه في التعامُل مع هؤلاء الكفَّار.
يقول المؤلِّف (ص: 47): (وفي شأن بلوغ الرسالة يقول ابن تيميَّة: (وقد ثبت بالكتاب والسُّنة والإجماع أنَّ مَن بلغته رسالة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فلم يؤمن به فهو كافر لا يُقبل منه الاعتذار بالاجتهاد؛ لظهور أدلَّة الرسالة وأعلام النبوة، ولأنَّ العذر بالخطأ حُكم شرعي...).
ثم أخذ يُناقش ابن تيميَّة في هذا الرأي قائلًا: (والحجج التي احتجَّ بها ابن تيميَّة في النصِّ السابق هي: 1- أن أدلَّة الرِّسالة وأعلام النبوَّة ظاهرة. 2- أنَّ الخطأ حُكم شرعي، والمؤاخذة فيه مرفوعة فقط لهذه الأمَّة دون غيرها. ويمكن أن يناقش الإمام في هاتين الحُجتين فيقال: أمَّا كون أدلَّة الرسالة وأعلام النبوَّة ظاهرة - كما يقول - فإنَّ ابن تيميَّة نفسه يقول في موطن آخر: (وقد يكون الخفاء والظهور من الأمور النسبية الإضافية، فقد يتَّضح لبعض الناس أو للإنسان في بعض الأحوال ما لا يتضح لغيره أو له في وقت آخر، فينتفع حينئذ بشيء من الحدود والأدلة، لا ينتفع بها في وقت آخر... أمَّا إذا كان بالمعنى الثاني الذي هو بلوغ الرسالة للنظر بشكل تفصيليٍّ، فنظر في الدليل تفصيلًا، ونظر في الرسالة وهو حريص على معرفة الحق واتباعه، ولكن يَحُول بينه وبين الاتباع شبهات قويَّة، ومعارضات عقليَّة لم يصل فيها إلى ما يطمئن إليه، فهل هذا يُعد كافرًا جاحدًا للحقِّ معرضًا عنه؟ فإن كانت الإجابة: نعم. فقد يعترض على هذا بأنَّ الحُجَّة لم تقم عليه حقًّا، فإنَّ هناك فرقًا بين (إبانة) الحُجَّة وبين (إقامة) الحُجَّة، فإذا كانت الحُجَّة واضحة ولم تكن قائمةً على النظر لمعارضات عقليَّة قويَّة مثلًا تَحول بينه وبين الإيمان ولكنَّه ليس بمكذِّب ولا جاحد، فصعب أن يُسمَّى هذا كافرًا، لا سيَّما والكافر في القرآن الكريم كله متوعَّد بالنار والعذاب.
إذا صحَّ هذا؛ فبالإمكان ألَّا يعد هذا - أيضًا - كافرًا تجري عليه أحكام الكفر؛ لأنَّنا لا نستطيع أن نقول: إنَّه عرَف الحقَّ حقًّا ثمَّ مع ذلك جحده ولم يتبعه.
وأيضًا قوله قبل ذلك (ص: 44 - 45) تأصيلًا لهذه المسألة: ((هل (بلوغ الرسالة) هو مجرَّد العلم الإجمالي بأنَّ هناك رسولًا دون نظر في التفاصيل؟ أو هو - أعني: بلوغ الرِّسالة - هو العلم بتفاصيل الرسالة وبمعجزة الرسول؟ وإذا كان بلوغ الرِّسالة هو العلم بتفاصيل الرسالة وبمعجزة الرسول؛ فهل يُشترط الخلوُّ من الشُّبهات والمعارض العقلي ليتمَّ العلم حقًّا بها، وإلَّا لم تكن بَلغتْه كما هي، وعلمها كما هي، أم لا؟... وإذا كان الكفر هو جحدَ الحقِّ، فكيف يجحد الحقَّ مَن لا يعلمه أصلًا أو مَن لا يعلمه حقًّا في نفس الأمر؟ وإذن فمَن لم تبلغه الرِّسالة حقًّا هو إلى أن يسمى (جاهلًا) أو غافلًا مطلقًا أقربُ من أن يسمى (كافرًا)، وبالإمكان أن يسمى باسم دِيانته فيقال له: وثني أو مشرك أو كتابي، بوذي أو هندوسي أو يهودي أو نصراني، فإذا عرف الحقَّ حقًّا وجحده، أو أعرض عنه؛ لسبب من الأسباب سُمِّي حينئذ كافرًا).
ثم يقول (ص: 50): (فخلاصة ما سبق إذن: أنَّ الكافر عند ابن تيميَّة هو كل مَن لم يؤمن سواء بلَغتْه الرسالة أم لم تبلغه، وسواء أكان مكذِّبًا لها أم كان غير مكذِّب، وسواء أكان متردِّدًا أو شاكًّا أو معرِضًا عن النظر لسبب من الأسباب، أو اجتهد فأخطأ في معرفة الحقِّ، أو حتى كان غافلًا الغفلة المطلقة. وكل هؤلاء الذين ينطبق على أحدهم لفظ (الكافر) تجري عليهم أحكام الكافر في الدنيا والآخرة إلَّا الغافل غفلةً مطلقة، فإنَّ عقوبته في الآخرة موقوفةٌ على بلوغ الرِّسالة، وإن كان داخلًا في جملة الكفَّار في الدنيا).
التعقيب:
أوَّلًا: المؤلِّف بنَى كتابه على نقد ابن تيميَّة كنموذج للخِطاب السَّلفي، وأحيانًا ما يذكر رأي الشَّيخ ابن عثيمين؛ لكونه من أشهر وأعمق قرَّاء ابن تيميَّة الذين تأثَّروا به في هذا الزَّمان - على حدِّ قوله – وذكر أنَّ كتابه (نقد لخطاب منتسِب للسَّلف، ولا يعني بهذا النقد بالضَّرورة السَّلفَ أنفسهم)، ولنا أن نسأل سؤالًا: هل ابن تيميَّة حينما يَحكي قولًا ما،ويقول عنه: (إنَّه قد ثبَت بالكتاب والسُّنة والإجماع)، ويأتي المؤلِّف ناقدًا هذا القول لابن تيميَّة، متجاهلًا الآياتِ والأحاديثَ والإجماعَ التي استدلَّ بها ابن تيميَّة، ولم يُخبرنا المؤلِّف: بثبوت هذه الأدلَّة من عدمِه، وهل أصاب ابن تيميَّة في استدلاله هذا أم أخطأ، وهل حقًّا ثبَت الإجماع أم لم يثبُت؛ هل يكون هذا نقدًا لابن تيميَّة، أم نقدًا لما ثبَت بالكتاب والسُّنة والإجماع؟! وهل هو ينقُد الكتاب والسُّنة والإجماع تحتَ ستار نقد ابن تيميَّة؟! أم أنَّه لا يَعتدُّ بهذا الإجماع أصلًا؛ لأنَّ المعتزلة قد خالفتْه، وهم لهم سلفهم ورِجالهم ومصادرهم أيضًا؟!
وإذًا فقوله: (الكافر عند ابن تيميَّة) يوهم أنَّ ابن تيميَّة فقط هو القائل بهذا، مع أنَّ ابن تيميَّة ذكر أنَّ هذا القول ثبَت بالقرآن والسُّنة وإجماع الأمَّة، فهلَّا أتى المؤلِّف بالآيات والأحاديث التي استدلَّ بها ابن تيميَّة ونَقَد استدلال ابن تيميَّة بها، أو هلَّا أثبت أنَّ هذا الرأي ليس مُجمَعًا عليه! ولكنَّه لم يفعل! وبالطبع لن نفعل نحن، ولن نأتي بالآيات التي استدلَّ بها ابن تيميَّة ولا بالأحاديث، ولن نذكُر مَن حَكَى الإجماع على ذلك؛ إذ هذا يطول جدًّا، كما أنَّه ليس هذا من مقصودنا، وهو موجودٌ في مظانِّه من كتُب الاعتقاد والفقه.
ومن ذلك أيضًا: إنكارُ المؤلِّف على شيخ الإسلام لَعْنَ اليهود والنصارى:
يقول السَّمهوري (ص: 60 - 61): (5- اليهود والنصارى ملعونون هم ودِينهم: ... فهذا تجويز من الشَّيخ لمن يَقتدي به في أن يلعن دِين اليهود ودِين النصارى، ويلعن أهلَ هذين الدِّينين؛ فكيف بدِين مَن سواهم؟! بل إنَّ الشَّيخ نفسه يمارس هذا، فيجهر بلعن النصارى ولعن دِينهم).
التعقيب:
أولًا: إذا أنكر المؤلِّف على ابن تيميَّة أنَّه يلعن اليهود والنَّصارى؛ فماذا يقول المؤلِّف عن قول الله تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ} [المائدة: 78]، وعن قوله سبحانه مخاطبًا بني إسرائيل: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (87) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ} [البقرة: 87، 88] وقوله عزَّ مِن قائل عنهم: {أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا} [النساء: 52]، وقوله: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ} [المائدة: 13]، وقوله: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا} [المائدة: 64] ... إلى غير ذلك من الآيات؟! وماذا يقول عن قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لعَن اللهُ اليهودَ والنَّصارَى؛ اتَّخذوا قُبورَ أنبيائهم مساجدَ))، وهو حديث متَّفق عليه، وغير ذلك من الأحاديث؟!
فهلْ أخطأ ابنُ تيميَّة حينما لَعَن مَن لعنه الله تعالى ولَعَنه رسولُه صلَّى الله عليه وسلَّم؟ أم المتَّهِم له والمشنِّع بذلك عليه، والناقد له، هو المخطِئ؟!
ثانيًا: أنَّ لعن ابن تيميَّة لدِين اليهود والنَّصارى إنَّما يتوجَّه إلى الدِّين الذي حرَّفوه وزعموا أنَّ هذا هو الدِّين، لا إلى دِينهم نفسه الذي أنزله الله تعالى؛ فأصل دين اليهود والنصارى الحقِّ هو الإسلام، ويوضِّح هذا بجلاء جواب شيخ الإسلام حينما (سُئل: عن رجل لَعَن اليهود، ولَعَن دِينه، وسبَّ التوراة: فهل يجوز لمسلم أن يسبَّ كتابهم، أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، ليس لأحد أن يَلعَن التوراة؛ بل مَن أطلق لعن التوراة فإنَّه يُستتاب، فإن تاب وإلَّا قُتِل. وإن كان ممَّن يَعرف أنَّها منزلة من عند الله، وأنه يجب الإيمان بها: فهذا يُقتل بشتمه لها؛ ولا تقبل توبته في أظهر قولي العلماء. وأمَّا إن لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان، فلا بأس به في ذلك؛ فإنَّهم ملعونون هم ودينهم، وكذلك إنَّ سب التوراة التي عندهم بما يبيِّن أنَّ قصده ذكر تحريفها مثل أن يقال: نُسخ هذه التوراة مُبدَّلة لا يجوز العملُ بما فيها، ومَن عمل اليوم بشرائعها المبدَّلة والمنسوخة فهو كافر: فهذا الكلام ونحوه حقٌّ لا شيء على قائله، والله أعلم) [مجموع الفتاوى (35/ 200)] ، وهذا هو الموافق للكتاب والسُّنة والإجماع، وليس ابن تيميَّة متفردًا بذلك، ولا لومَ عليه ولا تشنيع، بل اللوم والتشنيع على من خالف ذلك بسبب الفَهم الخاطئ لأصول الدِّين.
- ومن المُؤاخذات: عدَم تفريق المؤلِّف بين التأويل المعتبَر، والتأويل غير المعتبَر؛ فكلُّ مؤوِّل عنده معذور: يَظهر هذا في مواضعَ كثيرة من كتابه، وأظهرها: دِفاعُه عن الجَعد بن درهم - الذي زعم أنَّ الله تعالى لم يتَّخذ إبراهيم خليلًا، ولم يكلِّم موسى تكليمًا، وقتَلَه خالد القسريُّ بسبب هذا - بزعم أنَّه متأوِّل، وأنَّه يظنُّ نفْسَه على الحقِّ؛ ولذلك ثبَت على قوله حتى القَتْل! وتَكلَّف المؤلِّف جدًّا في تبرير نفي الجعد لصِفات الله تعالى بتأويل بعيد، بل صرَّح المؤلِّف أيضًا بنفي ما أثبتَه الله تعالى لنَفْسه سبحانه وأثبته له رسولُه صلَّى الله عليه وسلَّم من الخُلَّة عن الله تعالى؛ لأنَّ معناها – بزعْمه، وتأويله الخاطئ - لا يليق بالله تعالى، وبأنَّ كلام الله تعالى (التوراة) مخلوق؛ ليدافع عن الجعد بن درهم! وأنكر على الذين يُثنون على قاتله، بل يطلُب الترحُّم عليه أيضًا؛ لكونه متأوِّلًا، ويكفي أن ننقُل كلامه في هذه النقطة دون تعقيب:
يقول السُّمهوري (ص: 105 - 106): (أمَّا الزعم بأنَّ الجعد نفَى أن يكون الله اتَّخذ إبراهيم خليلًا، فهذا هو التعبير المستخدَم لتشنيع مذهب الجعد بن درهم، وهي طريقة معروفة بين أصحاب الفِرق؛ تُشنع بها فرقة مذهب الفرقة الأخرى بإساءة حكاية ما تقول تلك الفِرقة، وهو نمط معروف. إنَّ فحوى مذهب الجعد بن درهم أنه يقول: إنَّ الخُلَّة هي أقصى المحبَّة، والمحبَّة هي ميل المحبِّ إلى المحبوب والالتذاذ بمنافعه، وهذا المعنى لا يليق بالله تعالى، فنفسِّر الخُلَّة بإرادة الإحسان؛ لأنَّ المحبَّ يريد الإحسان إلى المحبوب، ففسَّرنا المحبَّة بلازم من لوازمها وهو إرادة الإحسان، وإذا كانت الخُلَّة هي أقصى درجات المحبَّة، فالخلة إذن تقتضي أقصى درجات إرادة الإحسان، وإذن فكون الله تعالى اتَّخذ إبراهيم خليلًا، معناه أنَّ الله تعالى يريد بإبراهيم من الإحسان ورِفعة الدرجة والذِّكر أكثر ممَّا يريد بغيره. وهذا القول يقول به عموم الأشعريَّة والماتريديَّة والمعتزلة والزيديَّة وغيرهم من المسلمين، فإذا كان الجعد قد استحقَّ القتل بسبب مقولته هذه، فأولئك كلُّهم يستحقُّون القتل مِثلَه. فلتقم المحاكم لهم، وليعد في كلِّ عيد أضحى من علماء تلك الفِرق ذبيح؛ لتزداد البهجة بالعيد على دِمائه، فيشكر الضحية (كل صاحب سنة)، وليقال للقاتل: (لله درُّك من أخي قُربان)! وأمَّا كون الله لم يُكلِّم موسى تكليمًا، ففحوى مذهب الجعد بن درهم أنَّه يقول: إنَّ الكلام فِعل المتكلِّم، وإذا كان فعلًا فهو حادثٌ يكون بعد أن لم يكن، والله تعالى قديم، وإذا كان قديمًا فيستحيل أن تقوم بذاته الحوادث، وإذن فالله تعالى فعَل هذا الكلام الذي هو حروف وأصوات في الشَّجرة فسمعه موسى ووعاه، فكان هذا كلامًا لله تعالى لم يوكل الله أحدًا بأن ينقله عنه، كواسطة، وإنَّما خَلَقَه في الشَّجرة مباشرة، وشبيه بهذا مثلًا كون الجني - إن صحَّ هذا - ينطق على لسان الإنسي، فكلام الجني في هذه الحالة يُنسب لفاعله ولا يُنسب لمن قام به، وفي العصر الحديث اليوم نسمع الواعظين على أجهزة التسجيل فيقوم كلامهم بالأجهزة، ولكنَّه كلام الواعظين وليس كلام الجهاز! وإذن فالكلام يُنسب لفاعله مباشرة وليس لمن قام به... ومن الجدير بالذكر هنا، أنَّ فضيلة العلامة العثيمين ذكر هذه الأبيات عن ابن القيِّم، وترحَّم على القسري القاتل، ولم يترحَّم على المخالِف المتأوِّل المقتول!).
وقلْ مثل هذا في جُلِّ ما ذكره المؤلِّف السمهوري في كتابه هذا، في حديثه عن المبتدِعة، ولا يحتمل المقام أن نُطيل بذكر أمثلة أخرى منها.
- ومن المؤاخذات: قوله (ص: 77): (... ولكن السُّؤال: ما معنى بلوغ العِلم أو الحُجَّة؟ هل بمجرَّد بيان الأمر للمخالف تكون الحجَّة قد قامت عليه؟ الواقع أنَّه ما دام هناك شبهات قويَّة ومعارضات قويَّة عند المخالف لا يمكن القول بأن الحجَّة قد قامت عليه، وليس انقطاع المخالف في مناظرة سببًا للقول بأن الحجَّة قد قامت عليه؛ لأنَّه قد ينقطع صاحب الحقِّ أحيانًا بسبب انبهار أو شرود ذهن أو مغالطة ذكية لم يستطع كشفها، أو غير ذلك من الأسباب؛ ولهذا فإقامة الحجَّة هو أمر لا يُدركه إلَّا المخالِفُ نفسه، هو نفسه يَعلم ما إذا كانت الحُجَّة قد قامت عليه أو لا، فإنْ أصرَّ على الكفر بعد إذ علم في نفسه وانكشف له وجه الحقِّ، فحينئذٍ فهو كافر، ولكن من ذا الذي يعلم ما في الصُّدور إلَّا الله؟! فليس الأمر سهلًا).
التعقيب :
المؤلِّف ذكر هذا السؤال والجواب تعقيبًا على كلام شيخ الإسلام في أنَّ من (أصرَّ على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر)، وهو اعتراض بعيدٌ كلَّ البُعد عن الصَّواب؛ فمَن ذا الذي سيعترف على نفْسه أنَّه قد قامت عليه الحُجَّة، ويقول: أنا علمت في نفسي وانكشف لي وجه الحقِّ، وأنا أجحده؟! وعليه فإنَّه كافر! بل إنَّ الله تعالى قد ذكَر أنَّ طبيعة النُّفوس التي لا تؤمِن أنَّها تستيقن في أنفسها الحقَّ ومع ذلك تجحده؛ قال تعالى: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا} [النمل: 14]، وأنَّهم في قرارة أنفسهم لا يُكذِّبون الرسول، ولكنَّهم يجحدون الحقَّ الذي أتى به؛ قال سبحانه: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} [الأنعام: 33]، ولمَّا أدرك المؤلِّف أنَّ الأمر صعب قال: (ولكن مَن ذا الذي يعلم ما في الصُّدور إلَّا الله؟!)، وعليه: فلا يعلم أيُّ عالِمٍ كُفْرَ أيِّ إنسان، ولا أنَّه قامت عليه الحجَّة أم لا، إنَّما الذي يعلم ذلك هو الله وحده؛ (فليس الأمر سهلًا)! وهذا كلام يؤدِّي إلى أقصى درجات التَّمييع، ولا يوجد مَن يُكفَّر في العالمين بهذا الاعتبار أصلًا. والحقُّ أن العلماء رحمهم الله تعالى اعتبروا بلوغ العلم أو الحُجَّة بعلامات ودَلالات واضحة، يغلُب على الظنِّ أنَّ مثل الشَّخص التي يُبلَّغ العلم أو تُقام عليه - يغلب على الظنِّ أن يَفهمها مثلُه، وكل مَن يفهم اللِّسان العربي، فإنَّه يمكن فهمه للقرآن، وليس فَهم كلِّ آية من القرآن فرضًا على كلِّ مسلم، وإنَّما يجب على المسلم أن يعلم ما أمره الله به وما نهاه عنه بأيِّ عبارة كانت، وهذا ممكن لجميع الأمم؛ ولهذا دخل في الإسلام جميعُ أصناف العجم من الفُرس والتُّرك والهند والصقالبة والبربر، ومن هؤلاء مَن يَعلم اللِّسان العربيَّ، ومنهم مَن يعلم ما فرَض الله. وكثير من الخَلق الذين يعلمون العربيَّة يفهمون القرآن بالعربيَّة، ويحتجُّون بآيات منه؛ فكيف يسوغ لهم مع هذا أن يقولوا كيف تقوم الحجَّة علينا بكتاب لم نفهمه؟ [ينظر: (الجواب الصحيح) لابن تيمية (2/ 66 -67)]، ومَن بلَغه القرآن، وقرأه وفَهِمه، وأنصف من نفسه، وتخلَّى عن الهوى، والكِبر، وتقليد الآباء، والحِرصِ على الدنيا، وغير ذلك من موانع الإيمان؛ فهو لا بدَّ مؤمن به. أمَّا من يتذرَّع لهم المؤلِّف بأنَّهم لم تقم عليهم الحجَّة ولم يبلغهم العلم (بسبب انبهار أو شرود ذهن أو مغالطة ذكية لم يستطع كشفها أو غير ذلك من الأسباب)، ويطلب بعد ذلك ألَّا نجزم بأنَّه بلغه العلم أو قامت عليه الحجة، فهذه هي المغالطةُ بعينها، وهذا هو الخَلل بعينه.
- ومن المؤاخذات إنكاره على شيخ الإسلام ابن تيميَّة تكفيره لأناس بأعيانهم، زاعمًا أنَّ ابن تيميَّة يخالف في الجانب التطبيقيِّ التنظيرَ الذي نظَّره من الفَرق بين تكفير المطلَق وتكفير المعيَّن، وأنَّه لا بدَّ من توافر الشُّروط وانتفاء الموانع لإطلاق الحُكم بتكفير أو تفسيق المعيَّن؛ يقول المؤلِّف (ص:80) : (معيَّنون كفَّرهم ابن تيميَّة: وفي إطار الجانب التطبيقي لإنزال الحُكم بالكفر على المعيَّن نجد أنَّ ابن تيميَّة مارَس التكفير عمليًّا على معيَّنين، أذكر أشهرهم فيما يأتي: ...
3- فلاسفة كفَّرهم ابن تيميَّة بأعيانهم: فهو يصف الفارابيَّ بأنَّه كافر ضالٌّ، ويكفِّر نُصير الدِّين الطوسيَّ، وصدر الدين القونويَّ، ويكفِّر ابن عربي وصاحبه الروميَّ، إلَّا أنَّه يتحرَّز في ابن عربي ويقول: (والله أعلمُ بما مات عليه). ويكفِّر أيضًا ابنَ الفارض وابنَ سبعين، كما يُكفِّر السَّهرورديَّ ويصفه بأنَّه صابئيٌّ محض).
التَّعقيب :
العلماء - ومنهم ابن تيميَّة - رحمهم الله حينما أصَّلوا الفَرق بين التكفير المطلَق والحُكم على المعيَّن بالكفر، من توافر الشُّروط وانتفاء الموانع، لم يقولوا: إنَّه لا يصحُّ إطلاق الكفر على المعيَّن، إذا تحقَّق المناط، ووُجدت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع؛ فالمسألة هنا هي في تحقيق المناط، بمعنى أنَّه إذا ثبت عند عالم معيَّن أنَّ فلانًا من النَّاس فعَل الكفر، وتوافرت فيه الشروط، وانتفت عنه الموانع، فله حينئذٍ أن يحكُم عليه بالكُفر، وهذا تتفاوت فيه أنظار العلماء بحسب ما عندهم من العلم بحال هذا الشَّخص، وعِلمهم بتوفُّر الشروط وانتفاء الموانع في حقِّه، أو عدم توفُّرها؛ فقد يتَّفق عالِمانِ على أمرٍ ما أنَّه كُفر، ولكنهما يختلفان في الحُكم على الشَّخص الذي فعل هذا الفعل الكفريَّ؛ إذ الذي كفَّره بعينه قد تحقَّق عنده المناط وعلِم من حال هذا الشَّخص أنَّه قامت عليه الحُجَّة التي يفهما مثلُه، وتوفَّرت فيه الشُّروط القاضية بكفره وانتفت عنه الموانعُ المانعة من الحُكم عليه بالكفر، بينما العالم الآخَر لم يتوفَّر عنده العلم بذلك فلم يحكُم عليه بالكفر. وعليه: فالذين ذكَرهم ابن تيميَّة وصرَّح بكُفرهم قد قامتْ عنده الدَّلائل على أنَّهم أتَوا كُفرًا، وأنَّ مثلهم تحقَّقت فيهم الشُّروط وانتفت عنهم الموانع، وقامت عليهم الحجَّة التي يفهمها مثلُهم؛ ومِن ثَم حَكَم بكفرهم عينًا، فلم يتناقض الشيخ، ولم يخالف تنظيرَه في الجانب التطبيقيِّ. وقد يخالفه في هذا الحُكم غيره من العلماء؛ بناءً على ما عنده من العلم بأحوالهم، ولا ضَير في هذا، فهذا باب اجتهاديٌّ أصلًا.
- ومن المؤاخذات: حديث المؤلِّف عن الفِطرة واختلاف تفسيراتها، وزَعْمه اضطراب شيخ الإسلام فيها: يقول (ص: 192): (... فهذا تصريح من ابن تيميَّة أنَّه يعني بالفطرة الإسلام، وهناك ما هو أصرحُ من هذا، إذ يقول بعد أن نقل كلامًا لابن عبد البر، يقول: (والدلائل على أنه أراد فطرة الإسلام كثيرة، كألفاظ الحديث التي في الصَّحيح، مثل قوله: (على الملة) و(على هذه الملة) ومثل قوله في حديث عياض بن حمار: (خَلقتُ عبادي حُنفاءَ كلَّهم) وفي لفظ (حنفاء مسلمين)، ومثل تفسير أبي هريرة وغيره من رُواة الحديث ذلك، وهم أعلمُ بما سمعوا). ويضيف: (وأيضًا فإنَّه لو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام لما سألوا عقب ذلك: (أرأيتَ مَن يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟)؛ لأنَّه لو لم يكن هناك ما يغيِّر تلك الفطرة لما سألوه، والعلم القديم وما يجري ما يجراه لا يتغير).
ثم يُعقِّب المؤلِّف (ص: 193) قائلًا: (ولكن المعلوم يقينًا وواقعًا وضرورة خلافُ هذا الذي يقوله ابن تيميَّة؛ فإنَّ الإنسان يُولَد من أبويه لا يعلم شيئًا، وينشأ طفلًا يسأل عن كلِّ ما حوله، ويسأل: يا أبي، كيف جئتُ؟ يا أمِّي، أين كنتُ؟ مَن أوجدني؟ وهكذا، فلو كانت فِطرته - وهو طفل - هي الإسلام لاستغنى بها عن هذه الأسئلة، دعْ عنك تصوُّرات الأطفال عن الله تعالى، وسؤالاتهم عنه: هل ينام؟ هل يأكل؟ هل يبكي؟ كيف شكلُه؟ هل هو قائم على هو قاعد؟ فلماذا لم يكفهم (إسلامهم الضروري الفطري) إذا كانت معرفة الله ضروريَّة جدًّا إلى الحدِّ الذي يدَّعيه ابن تيميَّة؟!)، ثم يقول (ص: 194): (... ومن هنا نعلم أنَّ الصَّواب كان مجانبًا لابن تيميَّة رحمه الله حين يقول: (فالنفس بفطرتها إذا تُرِكت كانت مقرَّةً بالإلهيَّة، محبَّة له، تعبده لا تشرك به شيئًا، ولكن يفسدها ما يُزيِّن لها شياطين الجن والإنس).
التعقيب:
المؤلِّف هنا يردُّ الأحاديث الصَّحيحة، الصَّريحة الواضحة البيِّنة الدَّلالة، ويردُّ فَهْم رُواتها من الصَّحابة كأبي هريرة رضي الله عنه، وفَهْم العلماء والأئمَّة الأكابر غير ابن تيميَّة، أمثال ابن عبد البر، بمثال الطِّفل الذي مثَّل به! وهو يظنُّ أنَّ معنى الفطرة أن يعلم الطفل الذي لا يعقل هذه الأمور، ويظنُّ أنَّ معنى الفطرة في الأحاديث أنَّ الطفل يُولَد يعلم الجواب عن كلِّ هذه الأسئلة التي ذكرها. ولا يَدري المؤلِّف أنَّ معنى الفطرة (أنَّ المولود يُولَد على نوع من الجِبلَّة، وهي فِطرة الله تعالى، وكونه متهيئًا لقَبول الحقِّ طبعًا وطوعًا، لو خَلَّته شياطين الإنس والجنِّ وما يختار، لم يختَرْ غيرها)، كما في ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 247) وغيره، ولم يقل أحدٌ: إنَّ المولود يولد عالمًا بهذه الأمور، أو قادرًا على استيعابها، وعليه: فلا وجه لردِّ الأحاديث الصَّحيحة ودَلالاتها الصَّريحة، وردِّ فَهْم الأئمَّة لها، وليُعلم أنَّ ردَّ الأحاديث الصحيحة وإنكار دَلالاتها الصَّريحة، هي صفة أهل البدع؛ ليثبتوا بدعَهم المخالفة لذلك، وهو منطبق على مسألتنا هذه لكلِّ متأمِّل.
- ومن المؤاخذات على المؤلِّف: نقده لكتاب شيخ الإسلام (درء تعارض العقل والنقل) بما هو منقود أصلًا؛ ونحاول هنا أن نُلخِّص النِّقاط التي ردَّ بها المؤلِّف على ابن تيميَّة، ثم نعقِّب على بعض تلك النِّقاط باختصار؛ فقد بنَى المؤلِّف في القسم الرَّابع من كتابه نقْده لكلِّ ما جاء في كتاب ابن تيميَّة (الدَّرء) على أمرين اثنين:
الأوَّل: أنَّ ظاهر النصِّ ليس هو النص، وعليه فالمتكلِّمون يقولون بتعارُض العقل مع ظاهر النص لا مع النصِّ نفسه، وعليه فلا تعارُض أصلًا، والخلاف الحقيقي بين شيخ الإسلام ابن تيمية والمتكلِّمين ليس بين النص والعقل كما صوَّره شيخ الإسلام، وإنَّما هو خلاف بين منظومتين عقليتين: إحداهما: تُثبت المعنى الظاهر للنص وتقدِّم الأدلَّة العقليَّة لإثبات هذا الظَّاهر وتُلغي ما عداها. والثانية: تثبت الأدلَّة العقليَّة التي تخالف ظاهر النصِّ وتؤول النصَّ بمعنى من المعاني التي يحتملها؛ ليتفق مع تلك الأدلَّة على ضوء أساليب العرب وطرائقها في الكَلام.
الثاني: أنَّ ابن تيميَّة حتى لو أصاب، فهو يردُّ عليهم ردًّا عقليًّا، فصحَّ بذلك تقديم العَقل على النَّقل.
وثمَّت نقد جزئي في كلِّ الأوجه التي نقلها، مع اعتراف المؤلِّف السَّمهوري لوجه واحد ممَّا ذكره ابن تيميَّة بأنَّه أقوى الوجوه.
يقول المؤلِّف (ص:413): (وتنبَّه أخي القارئ الكريم إلى أنَّ ابن تيمية حين يقول: (درء تعارض العقل والنقل)، فالنقل عنده ليس هو (النص) بعمقه وبما قد يحمله من معان متعدِّدة، بل النقل عنده أو النص أو الشرع إنَّما يقصد به (ظواهر النصوص) على التحديد، ولا شيءَ غير ظواهر النُّصوص؛ هذا لأنَّ علماء الكلام المسلمين يزعمون أنَّ ظواهر النصوص غير مُرادة في عديد من المواضع، لا سيما ما يتعلَّق بصفات الله تعالى، وهذا ما يُريد ابن تيميَّة أن يُبطله في هذا الكتاب، لكنني أقول وبصدق وعلى الرغم من حبي لابن تيمية رحمه الله واحترامي الشديد له، أقول: إنَّ ادعاء أن (ظواهر النصوص) هي (النصوص) نفسها إلغاءٌ لكل المعاني الأخرى التي قد تحملها النُّصوص، وتضييقٌ لسَعة القرآن).
ويقول (ص:441): (وحسْبُنا أن نرى وبشكل واضح أنَّ شيخ الإسلام رحمه الله لا يجادل ولا يثبت رأيه ولا ينقض قول الخصوم إلَّا بالأدلَّة العقليَّة، وهذا كاف جدًّا في أنه حتى القائلون بتأخير العقل عن النص لا يجدون ما يُثبتون به كلامهم إلَّا العقل؛ ذاك أنَّ النص ليس فيه تصريح البتة بما يفضُّ هذا النزاع، ولو أنَّهم وجدوا في القرآن أو في السُّنة آيةً واحدة صريحة فيما يُريدون، لاكتفوا بها دون الولوج في الأدلَّة العقلية أصلًا؛ فدعوى تأخير العقل بأدلَّة العقل نفسه تناقض بيِّن، وهذا وحده كاف في هذا القضية).
ويقول (ص:444 - 445): (لم يخطئ المتكلِّمون فيما قرَّروه، ولم يأت شيخ الإسلام بجديد حين نَسب إليهم الإقرار بامتناع المعارضة بين السَّمع والعقل، فإنَّهم يقرون بهذا، ولكن ابن تيميَّة رحمه الله يريد أن يجعل ظواهر النصوص هي النصوص نفسها، أمَّا المتكلمون فإنَّهم يقولون، إنَّه لا تعارض بعد التأويل، فالمعارضة مع (ظواهر النصوص) ليست معارضة مع (النصوص) نفسها، وإنَّما مع نوع من المعاني تحتملها تلك النصوص، وتحتمل غيرها، فإذا تعارضت الأدلَّة العقليَّة مع تلك المعاني، وكان بالإمكان حمل النصوص على معانٍ أخرى محتملة ومعقولة وجارية على سُنن العرب؛ فأين المعارضة؟!).
التعقيب: وها هنا لا بدَّ من توضيح بعض الأمور:
1- لماذا اختار المؤلِّف كتاب (درء تعارض العقل والنقل) بالذات؟
ونتولَّى هنا الإجابة عن ذلك؛ فكتاب (الدرء) لم يُؤلَّف على منواله مثله، وهو نهاية مطاف كتُب شيخ الإسلام ابن تيميَّة العقائديَّة، ومن أهمِّ كتبه، بل لعلَّه أهمها وأعظمها وأجلُّها على الإطلاق، بل أهم ما أُلِّف في موضوعه أصلًا؛ فإنَّه كتاب لم يَطرُق العالَمَ له نظيرٌ في بابه، وهو كتاب حافل عَظِيم الْمِقْدَار، ردَّ الشَّيْخ فِيهِ على الفلاسفة والمتكلِّمين، وبيَّن موافقة "العقل الصَّريح للنقل الصَّحيح"، وهدَم فيه قواعد أَهل الباطل من أُسِّها فخرَّت عليهم سقوفه من فوقهم، وشيَّد فيه قواعد أهل السُّنة والحديث وأحكمها، ورفَع أعلامها وقرَّرها بمجامع الطُّرق التي تقرَّر بها الحق، من العقل، والنقل، والفِطرة، والاعتبار- اتَّفق على هذا مترجمو شيخ الإسلام، ودارسو كتابِه وقارئوه؛ [ينظر: مقدِّمة المحقق الدكتور محمد رشاد سالم لكتاب (الدرء)، وطريق الهجرتين لابن القيِّم (ص: 155)، والعقود الدرية لابن عبد الهادي (ص: 41 - 42) ]. وقد ذكَر فيه ابن تيميَّة أعلام الفرق والمذاهب، حتَّى ﻻ يكاد يفوته منهم أحد له بال، وناقش كلًّا منهم في أهمِّ كتبه، وينقل عنهم بالصفحات بالنصِّ، ثم يردُّ عليهم ويفنِّد شُبههم، وقد كان لأبي عمر الرَّازي النَّصيب الأوفر من هذه الردود والمطارحات، وربما لم يترك له ابن تيميَّة كتابًا كلاميًّا إَّﻻاستدعاه وحاكَمه وغربله، حتَّى بعض الكتب التي لم تصل إلينا، وأولاه عناية خاصَّة؛ وذلك لأنَّه معوَّل الأشاعرة في زمانه وبعد ذلك إلى يومنا هذا، ويأتي في المرتبة الثانية من نقد ابن تيميَّة الإمام أبو بكر الباقلاني الذي يعدُّ بحقٍّ المؤسِّس الحقيقيَّ للمذهب الأشعري، وأهم شخصية عند الأشاعرة في العقيدة وأصول الفقه [ينظر:(سياحة في رحاب الدرء) للشيخ حمود العمري، وهو عبارة عن تغريدات نفيسة له بعد قراءته لكتاب الدرء] .
نقول: لهذا وغيرِه اختار المؤلِّف كتاب (درء تعارض النقل) ليكون محلَّ النقد؛ إذ المؤلف يُجهِد نفسه في نصرة مذهب المتكلِّمين، والمعتزلة خصوصًا، ولو صحَّ له اعتراضه على ما كتبه شيخ الإسلام في كتابه (درء التعارض) لنال المبتغَى، ولكن دون ذلك خرط القتاد! كما سيتضح بيانه في الآتي:
2- أمَّا زعم المؤلِّف السَّمهوري بأنَّ ظاهر النصِّ ليس هو النصَّ، وعليه فالمتكلِّمون يقولون بتعارض العقل مع ظاهر النصِّ لا مع النصِّ نفْسه: فهذا لم يغِب عن شيخ الإسلام ابن تيميَّة؛ بل في أوَّل كتابه أشار إلى هذا بقوله: (قول القائل: إذا تعارَضت الأدلَّة السَّمعية والعقليَّة، أو السَّمع والعقل، أو النَّقل والعقل، أو الظَّواهر النقليَّة والقواطِع العقليَّة، أو نحو ذلك من العبارات...)، وكتابه هذا جاء ليوضِّح أنَّ الأصل هو إجراء النُّصوص على ظاهرها، وأنَّ الأصل أنَّ ظاهر النصِّ هو المراد من النصِّ بعينه، وأنَّ هذا الظاهر هو ما كان يَفَهم السَّلف الصَّالح من الصَّحابة وتابعيهم بإحسان، وسائِر الأئمَّة المتَّبَعين، حتى الذين يقولون بالتأويل يقولون: إنَّ الأسلم هو إمرارُ النُّصوص على ظاهرها، وأنَّ هذا هو مذهب السَّلف. وأيضًا جاء كتاب ابن تيميَّة هذا ليبيِّن أنَّ ظواهر النُّصوص الصَّحيحة هو الموافق أيضًا لصَريح العقل، ويستحيل أن يأتي نصٌّ صحيح يخالف ظاهره العقل الصَّريح، وما ورَد وتوهِّم فيه ذلك التعارُض؛ فإمَّا أن يكون النصُّ في نفسه غير صحيح أو غير ثابت، وإمَّا أنْ يكون العَقل مخطئًا في ذلك وتوهَّم أنَّه معارض وليس الأمر كذلك. وما دلَّ الدَّليل الواضِح البيِّن من النُّصوص نفسها على أنَّه غيرُ مراد، فيؤوَّل بمعنًى صحيحٍ راجح، ويكون عليه أيضًا دليلٌ صحيح واضِح إما من نفس النصِّ أو من غيره، وهذا قليل، والمعروف أنَّ القاعدة للأغلب، وعليه فظاهر النصِّ هو النصُّ، ولا مُشاحَّة في الاصطلاح، والمتكلِّمون المتكلِّمون الذين ينصر المؤلِّف رأيهم يقولون: إنَّ ظواهر هذه النُّصوص ليست هي المُراد من تلك النصوص؛ لأنَّها مخالفة لقواطع العقل بحسب رأيهم، ولا بدَّ من تأويلها؛ لتتوافق مع تلك القواطع التي توهَّموها قواطع، وتوهَّموا أنَّها معارضة للنصِّ، وليست هي في الحقيقة بقواطع، بل هي مجرَّد أوهام، وغايتها ظنون لا يجزمون أنَّ هذا هو مراد اللفظ؛ يقول ابن تيميَّة عنهم في ((الدرء)) (1/ 12): (وهم في أكثر ما يتأوَّلونه قد يعلم عقلاؤهم علمًا يقينًا أنَّ الأنبياء لم يريدوا بقولهم ما حملوه عليه، وهؤلاء كثيرًا ما يجعلون التأويل من باب دفْع المعارض، فيقصدون حمل اللَّفظ على ما يمكن أن يُريده متكلِّم بلفظه، لا يقصدون طلب مراد المتكلِّم به، وحمله على ما يناسب حاله، وكلُّ تأويل لا يَقصد به صاحبه بيانَ مراد المتكلم وتفسيرَ كلامه بما يُعرف به مراده وعلى الوجه الذي به يُعرف مراده، فصاحبه كاذبٌ على من تأوَّل كلامه؛ ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون: يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ) .
بل أحيانًا يعبِّرون ب عبارات قد يفهم منها أنَّهم يعدُّون ظواهر النُّصوص هي النُّصوص نفسها، وهذه النُّصوص نفسها مخالفةٌ لقواطِع العَقل عندهم، وعليه فلا بدَّ من تأويلها، من ذلك قولهم: (الأدلَّة اللَّفظية لا تُفيد اليقين - الأدلَّة السَّمعيَّة - النُّصوص - السَّمعيات... إلخ)؛ وعليه فيصحُّ أن يُقال: تعارُض العقل والنَّقل، أو العقل والشَّرع، أو العقل والنَّص، وأنَّ المتكلمين قالوا بالتعارُض بينهما، وأوَّلوا النَّصَّ ليتوافق مع العقل، وهو ما أنكره ابن تيميَّة وجمهور السَّلف قبله وبعده. فلا يتَّجه نقد المؤلِّف لهذه النُّقطة .
ويوضِّح هذه النقطة بجلاء ابن القيِّم في ((الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)) (3/ 804 - 806) بقوله: (فإن قيل: بل المعارضة ثابتة بين العقل وبين ما يُفهم بظاهر اللَّفظ، وليست ثابتةً بين العقل وبين نفْس ما أخبر به الرَّسول، فالمعارضة ثابتة بين العقل وبين ما يظهر أنَّه دليل وليس بدليل، وأن يكون دليلًا ظنيًّا؛ لتطرُّق الظنِّ إلى بعض مقدِّماته إسنادًا أو متنًا. قيل: وهذا يرفع صورة المسألة ويُحيلها بالكليَّة وتصير صورتها هكذا: إذا تعارض الدَّليل العقليُّ، وما ليس بدليل صحيح، وجب تقديم العقلي. وهذا كلام لا فائدة فيه، ولا حاصل له، وكل عاقل يَعلم أنَّ الدَّليل لا يُترك لما ليس بدليل، ثم يقال: إذا فسرتم الدَّليل السَّمعي بما ليس بدليل في نفس الأمر، بل اعتقاد دَلالته جهل أو بما يُظنُّ أنَّه دليل وليس بدليل؛ فإن كان السمعيُّ في نفس الأمر كذلك؛ لكونه خبرًا مكذوبًا أو صحيحًا، وليس فيه ما يدلُّ على معارضة القول بوجه، وأثبتُّم التعارُض والتقديم بين هذين النَّوعين، فساعدناكم عليه وكنَّا بذلك منكم؛ فإنَّا أشدُّ نفيًا للأحاديث المكذوبة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وأشدُّ إبطالًا لما تحمله من المعاني الباطلة، وأولى بذلك منكم. وإنْ كان الدَّليل السَّمعي صحيحًا في نفسه ظاهر الدَّلالة بنفسه على المراد، لم يكن ما عارضه من العقليَّات إلَّا خيالات فاسدة، ومقدِّمات كاذبة، إذا تأمَّلها العاقل حقَّ التأمُّل، ومشى إلى آخِرها وجدَها مخالفةً لصريح المعقول، وهذا ثابت في كلِّ دليل عقليٍّ خالف دليلًا سمعيًّا، صحيح الدَّلالة، وحينئذ فإذا عارض هذا المسمَّى دليلًا عقليًّا السَّمعَ وجب إطراحه لفساده وبطلانه. ولبيان العلم ببطلانه طريقان كلي وجزئي: أمَّا الكلي: فنقطع بأنَّ كلَّ دليل عقلي خالف السَّمعي الصريح الصَّحيح، فهو باطل في نفسه، مخالف للعقل قبل أن ينظر في مقدِّماته. أما الجزئي: فإنَّك إذا تأملت جميع ما يدعوك به معارض السَّمع وجدتَه ينتهي إلى مقدِّمات باطلة بصريح العقل، لكن تلقَّاها معود عن معود، فظنوها عقليَّات، وهي في التحقيق جهل مركَّب، وحينئذ فالواجب تقديم الدَّليل السَّمعي للعلم بصحَّته، وما عارضه فإمَّا معلوم البطلان، وإمَّا غير معلوم الصحَّة، وذلك أحسن أحواله).
3- زَعْم المؤلِّف: ب أنَّ ابن تيميَّة حتَّى لو أصاب، فهو يردُّ عليهم ردًّا عقليًّا، فصحَّ بذلك تقديم العَقل على النَّقل ؛ أمَّا أنَّ ابن تيميَّة ردَّ على المتكلِّمين ردًّا عقليًّا؛ فنعَمْ، وهذا من محاسن الكتاب؛ إذ ردَّ على القوم بآلاتهم وأدواتهم التي يفتخرون بها، وضَحَد بها شُبههم. وهذا الرد العقليُّ من أهداف ابن تيميَّة أيضًا في كتابه، وقد جاء عنوان الكتاب على بعض مخطوطاته هكذا (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول)، وسمَّاه ابن القيِّم تلميذ ابن تيمية النجيب بـ(بيان موافقة العقل الصَّريح للنقل الصحيح) ومعناه ظاهر! وأمَّا أنَّ هذا يقتضي تقديم العقل على النصِّ، فهذا ليس بصحيح؛ إذ العقل الصَّريح قد أقرَّ للشَّرع وسلَّم له، وآمَن به، ووظيفتُه هي التدبُّر والتفكُّر في النُّصوص، وليست وظيفته أن يكون حَكمًا عليها؛ فإذا صحَّ النَّقل أو النصُّ، فليس للعقل أن يعترض عليه، أو على أفراد كلِّ نصٍّ بتوهُّماته التي يظنُّها قواطِع، وحتَّى إنْ عجَز عن إدراكها، فالواجب هو تقديم النَّقل والتَّسليم له، وردُّ المُحكَم إلى المتشابِه، وردُّ العلم إلى عالِمه. وقد فصَّل ابن تيميَّة في كتابه في هذه النقطة بما لا مزيد عليه، واعتراض المؤلِّف السُّمهوري عليه هو من جِنس اعتراض المتكلِّمين الذين ثبت بُطلان اعتراضهم.
وكذلك زعْمه (بأنَّ القائلين بتأخير العقل عن النصِّ لا يَجدون ما يُثبتون به كلامهم إلَّا العقل؛ ذاك أنَّ النصَّ ليس فيه تصريح البتة بما يفضُّ هذا النزاع) يردُّه صنيع ابن تيميَّة نفسه، في القاعدة الثالثة من قواعده التي ذكرها استغناء عن قواعد المتكلِّمين، وهي: الاكتفاء بما في النصِّ القرآني من حُجج وأقيسة دون الخروج عنها، وفي ضِمنها الحديثُ عن طريقة تقرير القرآن لمسائل أصول الدِّين . وكثيرًا ما يوضِّح ابنُ تيميَّة الأدلَّة العقليَّة من النُّصوص الشرعيَّة، وهذا معروف مشهور عنه لا يحتاج إلى تمثيل. والعجيب أنَّ المؤلف نفسه ذكر هذه القاعدة من كلام ابن تيميَّة، ثم أتى هنا ليقول إنهم لا يجدون ما يُثبتون به كلامهم إلَّا العقل...إلخ!
- من المؤاخذات كذلك: قوله (ص:389): (كذلك ربما يستشكل القارئ أنَّ ما نقلته عن المعتزلة من آراء يختلف مع بعض الأحاديث الآحادية التي يؤمن بها. أقول: الأحاديث الآحادية في هذه المسألة تبقى ظنيَّة الثبوت، وظنية الدَّلالة بل لو جمعت تلك الأحاديث لظهر فيها غير قليل من التناقضات والإشكالات).
التعقيب:
كلام المؤلِّف هنا خطأ من وجهين: الوجه الأوَّل: أنَّ أحاديث الآحاد - والمقصود بها غير المتواتر - الصَّحيح من أقوال أهل العلم والمحدِّثين أنَّها حُجَّة في العقائد والعبادات، وكونها ظنيَّةَ الثبوت وظنيَّة الدَّلالة لا يعني أنَّها ليست حُجَّة، أو أنَّه لا يجب العمل به مطلقًا، بل ما صحَّ منها بشروطه المعروفة عند المحدِّثين فهو حُجَّة، ويجب العمل به مطلقًا، خصوصًا ما كان في الصَّحيحين أو أحدهما. كما أنَّها إذا احتفَّت بقرائن تقويها أفادتِ العِلم اليقينيَّ. [ينظر في ذلك:ما سطَّره الإمام ابن حزم في كتابه ((الإحكام في أصول الأحكام)) (1/ 119 - 138)، والعلامة ابن القيِّم في كتابه((الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)) في مواضع كثيرة منه، والحافظ ابن حجر في كتابه (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر)(ص: 43 - 52)،والمحدِّث الألباني في كتابه الفرد (وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة)، وغير ذلك] .
الوجه الثاني: أنَّه لو صحَّ ما ذكره المؤلِّف من إسقاط حُجيَّة أحاديث الآحاد، فقد ثبَت خلاف ما نقله من رأي المعتزلة بالآيات القرآنيَّة الواضحة الصَّريحة، وقد سبق الإشارة إلى بعضها.
- من المؤاخذات على المؤلِّف كذلك: تعقيبه على قول ابن تيميَّة ( أمَّا النصوص التي يزعمون أنَّ ظاهرها كفر، فإذا تدبرت النصوص وجدتَها قد بيَّنت المراد، وأزالت الشُّبهة؛ فإنَّ الحديث الصحيح لفظه: ((عَبدي، مرضتُ فلم تعُدْني، فيقول: كيف أعودُك وأنت ربُّ العالمين؟! فيقول: أمَا علمت أنَّ عبدي فلانًا مرِض، فلو عُدتَه لوجدتَني عِندَه)). فنفْس ألفاظ الحديث نصوص في أنَّ الله نفسه لا يمرض، وإنَّما الذي مرض عبده المؤمن، ومِثل هذا لا يقال فيه: ظاهره أنَّ الله يمرض فيحتاج إلى تأويل؛ لأنَّ اللفظ إذا قُرِن به ما يبيِّن معناه كان ذلك هو ظاهره كاللَّفظ العام إذا قُرن به استثناء أو غاية أو صفة.. إلخ) – قال السَّمهوري معقِّبًا (ص:474 - 475): (لكن بإمكان المتكلِّمين أن يقولوا: لو أنَّنا عُدْنا إلى الحديث لوجَدْنا أنَّ هذا الحديث ذاته دليلٌ على أنَّه يجوز أن يكون هناك نصٌّ ظاهره غير مراد؛ فالله تعالى خاطب ذلك العبد بما ظاهره محالٌّ ونقص يتنزَّه الله عنه، وواضح أنَّ العبد المخاطَب في هذا الحديث لم يحمِل الكلام على ظاهره، بل نزَّه الله مباشرةً عمَّا لا يليق؛ ولهذا سأل: كيف أعودك وأنت ربُّ العالمين؟ كيف أُطعمك وأنت ربُّ العالمين؟ لقد استنكر هذا العبد ظاهر هذا الخطاب الموجَّه إليه، ولم ينظر نصًّا آخر يخرج هذا الخطاب عن ظاهره. ولو كان هذا العبد من القائلين بمذهب الإثبات والأخذ بظواهر النصوص، لظنَّ أنَّ الله يمرض حقًّا مرضًا يليق بجلاله وعظمته، ولما استنكر هذه الظواهر، ولقال على الفور: اللهمَّ إني أعتذر إليك أنك مرضت ولم أقُم بحقِّ العيادة والزيارة، وإني أستغفرك وأتوب إليك لأني لم أُقدِّم لك الطعام! إنَّه لا فرق بين هذا العبد الذي لم يأخذ بهذا النص على ظاهره وبين المتكلِّمين الذين يسلكون هذا المسلك في تنزيه الله تعالى عمَّا لا يلق به بناءً على أدلَّة عقليَّة تقوم على مقدِّمات ونتائج، كما أنَّ الذين يأخذون بالظواهر كالشَّيخ رحمه الله يبنون ما يقولونه على أدلَّة عقليَّة ذات مقدِّمات ونتائج. فحتى لو اشترطنا ألَّا يؤوَّل النص إلَّا بقرينة من النص نفسه، فإنَّ تلك القرينة لن يعرف أنها قرينة إلَّا بالعقل ودَلالة العقل نفسه، وهكذا فحتى لو كان الداعي إلى عدم الأخذ بالظواهر هي قرينة نص آخر، فهذا النصُّ الآخر لن يُعرف كونه قرينةً إلَّا بالعقل ودلالة العقل، وهكذا يبقى العقل هو المُقدَّم).
فنقول: بل إنَّ هذا الحديث أصلٌ في أنَّ الأصل أن تُحمَل النصوص على ظاهرها؛ ولذلك لمَّا استشكل العبد هذه اللفظة التي هي نقصٌ صريح في حقِّ الإله العظيم سألَ عنها العالِمَ بها، فأُجيب بالمراد منها، وفرْق كبير بين هذا العبد وبين منهج المتكلِّمين؛ إذ هذا العبد سأل الله تعالى العليمَ الحكيمَ بمراده، فأجابه الله تعالى، ولم يُشبِّه أولًا أو يتخيَّل خيالات ويتوهَّم أوهامًا من تلقاء نفسه، ثم ينفي صِفات الله تعالى بزعم التنزيه. على أنَّ المتكلمين حينما ينفون الصِّفات عن الله تعالى، هم في حقيقة الأمر لا ينفون عنه سبحانه نقصًا أو عيبًا صريحًا، بل ينفون عنه ما توهَّموه نقصًا وعيبًا؛ بناءً على أنَّهم شبَّهوا أولًا، وافترضوا لوازم ليستْ بلازمة في حقِّ الله تعالى؛ إذ الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السَّميع البصير، ثم بعد ذلك اضطرُّوا على التحريف (التأويل) ثم التعطيل. وأمَّا أهل السنة وأتباع السلف الصالح فيقولون في إثبات صفة اليدِ على سبيل المثال: لله سبحانه وتعالى يدٌ حقيقةً، ثبتَتْ في نصوص كثيرة، وإنِ احتمل بعضها التأويل، فبعضها نصٌّ لا يحتمل تأويلًا بأيِّ حال، كقوله تعالى:{وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67]، وغير ذلك من نصوص الكتاب والسُّنة الكثيرة، وهي صفة كمال، ولا يَعلم كيفيتها وحقيقتَها إلَّا الله تعالى، ولا يلزم من إثباتها له سبحانه الزَّعم بأنَّ حقيقة اليد كذا وكذا، وعليه فلا بدَّ للمتَّصف بها أن يكون كذا كذا، ممَّا هو مذكور في كتب القوم ولا نحب ذِكره هنا؛ فهذا هو التشبيه والتمثيل الذي يؤدِّي إلى التحريف والتعطيل، بل يَكفينا أن نُمرَّها صريحةً كما أتت، مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف، ونعتقد أنَّ الله تعالى ليس كمثله شيء. وبهذا تواترت النصوص عن سلف الأئمَّة وأئمَّتها في العلم والدِّين أنهم قالوا: (أمروها كما أتت).
وقول المؤلِّف: (وهكذا فحتى لو كان الداعي إلى عدم الأخذ بالظواهر قرينة هي نص آخر، فهذا النص الآخر لن يعرف كونه قرينة إلَّا بالعقل ودلالة العقل، وهكذا يبقى العقل هو المقدَّم) كلام ليس في محلِّ النزاع؛ إذ النزاع في عدَم الأخْذ بالظاهر بمجرَّد توهُّمات العقل، والزعم بأنَّ ظواهر النصوص تخالف قطعيَّات العقل، وليس المنفيُّ إعمال العقل في النصِّ بالتدبُّر والتأمُّل والفهم، الذي يؤدِّي إلى التسليم بظواهر النصوص، أو إلى الجمع بينها ليتفهم مراد الله جلَّ وعلا منها.
- ومن المؤاخذات كذلك: الخَلَل الواضح في تفسير آيات الله تعالى؛ لتوافق ما يدَّعيه، أو لتوافق ما ينصره من مذهب المعتزلة. وسنضرب على ذلك مثالًا لتفسير المؤلِّف لآيتين كريمتين، ممَّا يبيِّن تناقض المؤلِّف والخَلَل الواضح عنده في فَهم آيات الله تعالى وتفسيرها.
الأولى: قوله (ص: 127) : (وكذلك نجد أنَّ ابن تيمية رحمه الله تعالى يميل إلى أن يفسر قول الله تعالى: {وخُلق الإنسانُ ضعيفًا}، نرى أنَّ معنى هذه الآية عنده (أي: ضعيفًا عن النِّساء لا يصبر عنهنَّ). وتأمَّل هنا كيف أنَّ الله يتكلَّم عن ضعف الإنسان (أي: نوع الإنسان) بكل ما يندرج تحته ممَّا يصحُّ أن يوصف بأنَّه إنسان، لكن ابن تيميَّة هنا يحمل لفظ (الإنسان) على (الذَّكر) فقط، وكيف أنَّه جعل الضعف الإنساني هو أنه لا يصبر عن المرأة، فكأن الإنسان هو الذكر فقط! وهذا تفسير ذُكوري محض للفظة تحتمل الذَّكر والأنثى، وتحتمل كلَّ ما يُطلق عليه أنَّه إنسان. ولكنَّها ثقافة العصر؛ ولذا اختار ابن تيميَّة هذا التفسير، وإن كان قد سبقه به طاووس بن كيسان من التابعين رضي الله عنهم).
والثانية: قوله: (ص:390 - 391): (ولعل القارئ الكريم هنا يستحضر بعض آيات القرآن الكريم التي يثبت فيها أن الله {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} ولستُ أريد أن أستعرض كلَّ آية في القرآن الكريم ولكنَّ المرجوَّ من القارئ الكريم أن ينظر في السِّياق التي وردت فيها هذه الآية وأشباها، فسيجد أنَّها تتكلَّم عن خلق الأجسام والكائنات، ولا تتكلَّم عن أفعال العباد...).
التعقيب:
من الأصول المقرَّرة في علم أصول التفسير: أنَّ العبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب. ومن ذلك: أنَّ تفسير السَّلف والأئمَّة أحيانًا يكون بذِكر بعض أنواع من الاسم العام على سبيل التَّمثيل، وأحيانًا يذكرون بعض أنواع المسمَّى وأقسامه، ولا ينفي هذا دخول ما عدا ذلك من الأنواع في معنى الآية. ومن ذلك: مراعاة سياق الآيات التي وردتْ فيها أيضًا. وأنَّ القرآن يُفسِّر بعضُه بعضًا. وغير ذلك من الأصول المقرَّرة في ذلك [ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيميَّة].
ففي الآية الثانية - لمَّا نصر المؤلِّف قول المعتزلة بأنَّ الله تعالى لا يخلُق أفعال العباد، وأنَّ العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، واستحضر الآيات الصَّريحة الواضحة التي تخالف ذلك - أراد أن يَخرُج من هذا المأزق، فلم يجد إلَّا أن يُخطِّئ الذين يستدلُّون على خلْق الله تعالى لأفعال العباد بقوله تعالى: {اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} بزعم أنَّهم لم ينظروا إلى السِّياق التي وردت فيه الآية، بل وغيرها من الآيات! وأنَّهم لو نظروا لوجدوها تتكلَّم عن خلْق الأجسام والكائنات، ولا تتكلَّم عن أفعال العباد!
وهذا من العجب العجاب؛ فمِن المعلوم في العربية أنَّ لفظ (كل) من أشمل ألفاظ العموم، وهي أمُّ الباب! كما أنَّه بالنظر إلى السِّياق في قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} [الزمر: 62] - وهذه آية ممَّا ورد فيه قوله تعالى: {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} - نجد أنَّها جملة جديدة، وكلام مُستأنَف في بداية تقرير الله تعالى لاستحقاقه العبادة دون ما سواه؛ إذ هو سبحانه الخالقُ لكلِّ شيء بما في ذلك العباد وأفعالهم، وأنَّ غيره من المعبودات لا يستحقُّ من العبادة شيئًا؛ لأنَّهم لا يَقدِرون على خلْق شيء. ثمَّ لو سلَّمنا بأنَّ سياق هذه الآية لا يدلُّ على أنَّ الله تعالى خالق أفعال العباد، ولم نأخذ بعموم اللَّفظ، فهناك آيات صريحة واضحة تدلُّ على أنَّ الله تعالى خالق أعمال العباد، مثل قوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: 96]، وهو وارد في سياق محاجَّة إبراهيم لقومه وإبطال عبادتهم للأصنام، بأن الله تعالى خلقهم وخلق عَمَلهم، أو خلقهم وخلق الذي يعملونه من الأصنام التي يشركون بها- على الوجهين المذكورين في معنى (ما).
وفي الآية الأولى يُنكر المؤلِّف على ابن تيميَّة تفسيرَه لقوله تعالى: {وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا}، بقوله: (أي: ضعيفًا عن النسِّاء لا يصبر عنهنَّ)؛ ليشنِّع عليه ويتَّهمه بما هو منه بَراء، وينسبه إلى موافقة طبيعة عصره التي تعني الجهل والتخلُّف، واحتقار المرأة - على حسب رأي المؤلِّف! ولذلك فابن تيميَّة يفسِّر القرآن تفسيرًا ذُكوريًّا! والمؤلِّف يردُّ عليه هنا بقاعدة عموم اللَّفظ، مع أنَّه لم يقل به في الآية الثانية التي فيها لفظ (كل)، وهي أمُّ الباب في ألفاظ العموم! وادَّعى هناك أنَّها مخالفة للسِّياق، ونسِي هنا أن ينظُر إلى السِّياق التي وردتْ فيه الآية، وأنَّ الكلام فيه كان عن إباحة نِكاح الإماء إذا لم يَستطع الرَّجُل نكاحَ الأحرار، وأنَّ هذه الإباحة لكون الإنسان الذَّكر خُلق ضعيفًا عن النِّساء لا يصبر عنهنَّ، فما ذكره ابن تيميَّة هو المناسب للسِّياق، على أنَّ ابن تيميَّة لا يُنكِر عمومَ الآية وجواز اشتمالها لكلِّ ضعف، بل إنَّه يستشهد بها في كثير من المواضع على أمور أخرى بعمومها [ينظر على سبيل المثال: الجواب الصحيح (1/ 150)، و مجموع الفتاوى (8/ 202)، وغيرها من المواضع] ، فهو حينما فسَّر الآية على حسب سياقها لم ينفِ عموم لفظها. وممَّا يبيِّن خطأ المؤلِّف وتدليسه أيضًا أنَّ شيخ المفسِّرين ابن جرير الطبريَّ ذكر هذا المعني نفسه عند تفسيره لهذه الآية (8/ 215 وما بعدها)، ثم قال: (وبنحو الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويل)، وذكر منهم: مجاهدًا، وابن طاوس، وابن زيد. ولم يذكر ابن جرير خلافًا في ذلك، ومن عادته أن يذكُر الخلاف؛ فليس هذا قول ابن تيميَّة وطاوس بن كيسان فقط. ولكنَّه الهوى يُعمي ويُصم! وهناك أمثلة أخرى في الكتاب تدلُّ على الخلل الواضح عند المؤلِّف في التفسير، ولكن يكفي هنا ما ذُكر للدَّلالة على ما سواه.
- ومن المؤاخذات على المؤلِّف: ما ادَّعاه على شيخ الإسلام في آخر الكتاب في فصل (إستراتيجيات ابن تيميَّة في ردِّه على المتكلمين)، حيث قال (ص: 501): (4- إستراتيجية التدعيم والحشد، بسرد عشرات النقول الواردة عن الأئمَّة، أو بدعوى أنَّ هذا قول عامَّة الطوائف، أو جماهير العقلاء، أو جماهير المسلمين، أو أتباع الأنبياء... إلخ. ولن أفصِّل فيها فيكفي العودة إلى كتاب (درء التعارض) أو غيره؛ ليظهر هذا للقارئ، لكن حسبي أن أُشير ها هنا ببنان التنبيه إلى أنَّ كثرة النقول وسَوْقها بهذا الشكل الضخم المبالَغ فيه، وكذلك التهويل والتزيُّد في كثرة القائلين يدلُّ على الاحتياج الشديد لذلك، وهذا له دَلالات لا تخفى على الناظر).
التعقيب:
المؤلِّف هنا يذمُّ شيخ الإسلام ويلمزه بما يُمدح به؛ إذ هذا من كثرة محفوظ ابن تيميَّة، ومن الجميل الذي أسداه للأمَّة بحفظ هذه النقول وتدوينها عن السَّلف والأئمَّة - ممَّا عُرف في ترجمته - ولأهميَّة المسائل، ولأهميَّة ما يريد شيخ الإسلام أن يثبته يُكثِر من النقول، وحقًّا هذه النقول وسرْدها بهذه الكثرة يُحتاج إليها جدًّا، خصوصًا للردِّ على أمثال المؤلِّف؛ ليثبتَ له ما يزعمه أنَّه تهويل. والنقد الذي كان ينبغي أن يوجَّه لمثل هذه النقول مثلًا: أن يزعُم المؤلِّف أنَّ ابن تيميَّة يكذِب على الطوائف والأئمَّة ويأتي بأشياءَ من كيسه وليست من قولهم. أو أن يقال: إنَّ هذه الأقوال لا تصحُّ عنهم. أو يقال: هذه الأقوال ثابتة عنهم، ولكنَّها ليست صحيحة المعنى ولا الدَّلالة، أو أنَّ ابن تيميَّة استدلَّ بها في غير موضعها، أو ما أشبه. ولكن المؤلِّف لم يفعل! واكتفى بالإشارة إلى كثرة النقول فقط؛ فهل هذا يُعاب على شيخ الإسلام، أم يُمدح به الشَّيخ، ويُشكر عليه، خُصوصًا إذا استحضرنا إتقانه لمحفوظه، وحُسنَ استدلاله بما في صدره من العلم، وغير ذلك ممَّا هو مذكور عنه في ترجمته؟!
وختامًا نقول: إنَّ مَن يتحرَّ الخير يُعطَه؛ فمَن أراد الحقَّ، وتحرَّى الوصول إليه، وبذَل ما استطاع من أسباب، هداه الله تعالى سُبلَه، والحق لا يُعرف بالرِّجال، بل الرِّجال هم الذين يُعرَفون بالحق، وليس الدِّفاع عن شيخ الإسلام ابن تيميَّة يعني أنَّه ليس معصومًا؛ بل هو بشر كسائر البشر يُصيب ويخطئ، ولكن حسْبه أنَّ صوابه أكثر من خطئه، وحسْبه أنَّ الله تعالى أعْلى ذِكره، وشهِد بفضله وتقدُّمه في العلوم النقليَّة والعقليَّة خصومُه وأعداؤه قبل أتباعه ومحبِّيه، فليس من الهيِّن اتِّهام هذا الإمام بالتناقُض، وغير ذلك ممَّا نسبه إليه المؤلِّف من أمور، وأيضًا فكما قدَّمْنا: ليس ابن تيميَّة في هذا السَّبيل بأوحد، والطَّعن على كثير ممَّا قرَّره هو في حقيقة الأمْر طعنٌ على سلف الأمَّة وعلمائها كلِّهم أيضًا، إنْ لم نقُل على الكتاب والسُّنة أيضًا؛ إذ ابن تيميَّة مقرِّر لأقوالهم، وتابع لمنهاجهم، ولا بدَّ من التفريق بيْن ما قيل: إنَّ ابن تيميَّة تفرَّد به وشذَّ فيه عن مجموع الأمَّة - وهو نذر قليل؛ بغضِّ النظر عن كونه فعلًا شذَّ أو لم يشذَّ، أو أصاب فيه أو أخطأ، أو أنَّ له عذرًا في ذلك أو لا، وبغضِّ النظر عن صحَّة الحُجج التي يقدِّمها على ما يقول أو عدم صحَّتها - فالخَطْب يسير في الاعتراض على هذه الأقوال ونقدها، وأمَّا ما قرَّره من دَلالات الكتاب والسُّنة وعُلِم أنَّه اتَّفق عليه سلف الأمَّة وأئمَّتها قبل ابن تيميَّة وبعده أيضًا، فهذا الطَّعن فيه لا شكَّ أنَّه طعنٌ على الأمَّة كلِّها، وليس على ابن تيميَّة في حقيقة الأمْر.
والله الهادي إلى سواء الصِّراط.