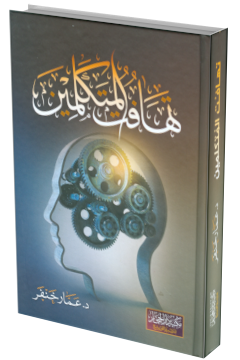التَّعريفُ بموضوعِ الكتابِ:
ظهرَت بعد القرنِ الهِجريِّ الأوَّلِ فِرَقُ المتكَلِّمةِ من الجهميَّةِ ومن نحا نحوَهم من المُعتَزِلةِ والأشاعرةِ والماتُريديَّةِ، وخاضوا في متاهاتِ الفلسفةِ؛ فضلُّوا وأضلُّوا، ولوَّثوا الفِطَرَ وأفسدوا مقاصِدَ الدِّينِ بما جلَبوه من فلسفاتٍ. فما كانوا أحذَقَ فِكرًا، وما كانوا أهدى سمعًا، ولا نصروا عقلًا، ولا لزِموا شرعًا، ولا جلَبوا لأنفُسِهم ولا لغيرِهم خيرًا ولا نفعًا؛ فصدَقُ فيهم قولُ اللَّهِ تعالى: {الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 104].
ومع ذلك وقع كثيرٌ من النَّاسِ في فتنةِ الفلسفةِ ومناهجِ الكلامِ خُصوصًا في المسائلِ المتعَلِّقةِ بالذَّاتِ والصِّفاتِ الإلهيَّةِ، ومن ذلك مسألةُ التَّحيُّزِ والجهةِ والجسمِ، وقيامِ الحوادثِ وتسلسُلِها، وغيرِ ذلك من مسائِلَ كان مستنَدُهم الوحيدُ فيها إثباتًا أو نفيًا هو ما أسْموه بالدَّليلِ العقليِّ، وجَعْلُه مقياسًا ومعيارًا للحُكمِ على ما يتعلَّقُ باللهِ تعالى صِحَّةً أو خطَأً دونَ اعتمادٍ على صريحِ الوحيِ وصحيحِ النَّقلِ، وإلَّا فالعقلُ الصَّحيحُ لا ينافي الدَّليلَ الصَّحيحَ مُطلقًا.
وقد جاء هذا الكتابُ ليُبَيِّنَ للنَّاسِ تهافُتَ ذلك المذهَبِ الكلاميِّ البِدْعيِّ، ويكشِفَ به مؤلِّفُه حقيقةَ منهجِه المستورَدِ من فلسفاتِ الأمَمِ الأخرى، والمخالِفِ لمنهجِ الوحيِ القائمِ على الوضوحِ والبساطةِ مع العُمقِ، دونَ تكلُّفٍ أو تعقيدٍ، ودونَ الخوضِ في مسائِلَ غيبيَّةٍ ليس فتحُ بابها من مقاصِدِ الدِّينِ، ولا كُلِّف العبادُ بالدُّخولِ فيها والبحثِ والسُّؤالِ عنها، وهي لا تزيدُ العبدَ إيمانًا ولا تمنحُه نورًا ويقينًا، وإنما هي ظلُماتٌ وتخبُّطٌ وضلالٌ وشُكوكٌ، وشُبُهاتٌ وتناقُضاتٌ.
وهذا الكتابُ مُقَسَّمٌ إلى ثلاثةِ أبوابٍ، تحدَّث مؤلِّفُه في البابِ الأوَّلِ منها عن بعضِ الأصولِ والمسائلِ الكلاميَّةِ للمتكَلِّمين، وبيانِ أوجُهِ الفسادِ فيها، وانعكاسِ ذلك على سائرِ حُجَجِهم وأدلَّتِهم وأصولِهم الأخرى. وفيه ثلاثةُ فُصولٍ:
أوَّلُها: في الحيِّزِ والجهةِ، وفيه تعريفُ بعضِ المتكَلِّمين للحيِّزِ، كالرَّازيِّ، ونقدُ هذه التَّعريفاتِ، ومناقشةُ حُجَجِ أصحابِها والرَّدُّ على شُبُهاتِهم.
والفَصلُ الثَّاني: يتحدَّثُ عن الجوهَرِ والعرَضِ، وفيه عرضٌ لمذاهِبِ المُتكَلِّمين، ثمَّ مذاهِبِ الفلاسفةِ في هذا الشَّأنِ، وعَرضُ بعضِ شُبُهاتِ الأشاعرةِ حولَ الجِسمِ والعَرَضِ، والرَّدُّ عليهم.
والفَصلُ الثَّالثُ: يتحدَّثُ عن الحوادِثِ ونفيِ المُتكَلِّمين قيامَ الأفعالِ الحادثةِ باللهِ تعالى، وما يتعلَّقُ بذلك من موضوعاتٍ عن الزَّمَنِ والأزَلِ، وقِدَمِ العالَمِ، وتسلسُلِ الأفعالِ، وغيرِها.
وعرَض المؤلِّفُ في البابِ الثَّاني أشهَرَ الحُجَجِ العقليَّةِ التي تمسَّك بها المُتكَلِّمةُ في نفيِ عُلُوِّ اللهِ على خَلقِه، مع الرَّدِّ على تلك الحُجَجِ، وبيانِ فسادِها. وذلك في ستَّةِ فُصولٍ حوى الأوَّلُ منها مقدِّمةً في بيانِ العلمِ وكيفيَّةِ حصولِه، تحدَّث فيها المؤلِّفُ عن البديهيَّاتِ والأوليَّاتِ، والحِسِّيَّاتِ والمستحيلاتِ، والضَّروريَّاتِ والنَّظريَّاتِ، والأوهامِ والخيالاتِ، وغيرِ ذلك.
والفَصلُ الثَّاني: يتحدَّثُ عن علُوِّ اللهِ تعالى بين الضَّرورةِ والنَّظَرِ، وقد أورد فيه المؤلِّفُ أنَّ للمُتكَلِّمين في مسألةِ المكانِ للهِ تعالى مذهبانِ: الأوَّلُ: أنَّ اللهَ تعالى موجودٌ في كلِّ مكانٍ. والثَّاني: أنَّ اللهَ تعالى لا في مكانٍ، فلا يقالُ: إنَّ اللهَ تعالى داخِلَ العالَمِ ولا خارِجَه. ثمَّ بيَّن المؤلِّفُ بطُلانَ القولِ الأوَّلِ بداهةً، وأنَّه لا حاجةَ لمناقشتِه، ثمَّ ناقش المذهَبَ الثَّانيَ الذي هو مذهَبُ أكثَرِ المُتكَلِّمين من المعتَزِلةِ والأشاعرةِ وغيرِهم، فأورد مقَدِّماتٍ وحُجَجًا للرَّازي مع الرَّدِّ عليها؛ لأنَّ الرَّازيَّ -بحسَبِ كلامِ المؤلِّفِ- قد توسَّع في هذه المسألةِ أكثَرَ من أيِّ مُتكَلِّمٍ وفيلسوفٍ آخَرَ مِن قَبلِه أو بَعدِه. وقد ذكَر المؤلِّفُ في نهايةِ هذا الفصلِ أنَّ المُتكَلِّمةَ على اختلافِ فِرَقِهم لم يقدِّموا دليلًا واحدًا على صحَّةِ كلامِهم، وكُلُّ حُجَجِهم مبنيَّةٌ على القياسِ على الممكِناتِ الموجودةِ في العالَمِ، فليست لديهم أيُّ حجَّةٍ على نفيِ فوقيَّةِ اللهِ تعالى.
والفَصلُ الثَّالثُ: يتحدَّثُ عن مسألةِ رؤيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ فمن أشهَرِ تناقضاتِ المُتكَلِّمين قولُهم بجوازِ رؤيةِ اللهِ تعالى في الآخرةِ مع اعتقادِهم نفيَ الجهةِ عن اللهِ تعالى؛ إذ كيف يمكِنُ رؤيةُ الشَّيءِ إذا لم يكُنْ في جهةٍ؟! ثمَّ إنَّهم حاولوا تبريرَ هذا التَّناقُضِ بأقوالٍ عرَضها المؤلِّفُ ورَدَّ عليها.
وجاء الفصلُ الرَّابعُ لعَرضِ أشهَرِ حُجَجِ المُتكَلِّمين التي يعوِّلون عليها في نفيِ العُلُوِّ والتَّحيُّزِ والاختصاصِ بجهةٍ، مع مناقشتِها والرَّدِّ عليها، وذلك بالاقتصارِ على إيرادِ ما ذكره فخرُ الدِّينِ الرَّازيُّ في كتابَيه: "المطالِبُ العالية" وهو آخِرُ كُتُبِه، و"الأربعين في أصولِ الدِّين" الذي ألَّفه لابنِه؛ ليُعلِّمَه طرائِقَ هذا الفَنِّ، دونَ عرضِ كلامِ غيرِه من المُتكَلِّمين؛ لعِدَّةِ أسبابٍ ذكَرها المؤلِّفُ.
وأمَّا الفصلُ الخامِسُ فقد تطرَّق فيه إلى ما قاله المُتكَلِّمون عن التَّجسيمِ والتَّركيبِ؛ لأنَّهم قرَّروا أنَّ إثباتَ عُلوِّ اللهِ تعالى يقتضي التَّركيبَ والتَّجسيمَ، وهذا عندَهم معتَقَدٌ باطِلٌ، فيلزَمُ منه عدَمُ إثباتِ عُلُوِّ اللهِ تعالى؛ فعَرض المؤلِّفُ حُجَجَ الرَّازيِّ في هذه المسألةِ، وبيَّن أنَّه وقع في تناقُضاتٍ وشُبُهاتٍ وظُنونٍ مجرَّدةٍ لا تورِثُ يقينًا.
وفي الفصلِ السَّادِسِ: نقَد المؤلِّفُ مذهَبَ المُتكَلِّمين في قولِهم بالجوهَرِ والعَرَضِ لإثباتِ حُدوثِ العالَمِ، فبيَّن تهافُتَ الاستدلالِ بذلك على ضوءِ العِلمِ الحديثِ الذي يُبطِلُ نظريَّاتِهم الكلاميَّةَ في هذه المسألةِ، ومن ذلك إثباتُ العلمِ الحديثِ قابليَّةَ الذَّرَّةِ للانقسامِ والانشطارِ.
وأمَّا البابُ الثَّالِثُ: فقد تضمَّن خمسةَ فُصولٍ عُقد أوَّلُها في سبَبِ قولِ المُتكَلِّمةِ بالدَّليلِ العقليِّ، وبيَّن المؤلِّفُ فيه بطلانَ الاستنادِ على الدَّليلِ العقليِّ المجرَّدِ، وذكَر ستَّةَ إشكالاتٍ يقعُ فيها من يُعمِلُ العقلَ فقط ويجعَلُه حاكِمًا على النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ.
والفصلُ الثَّاني: في طرائِقِ الاستدلالِ عندَ المُتكَلِّمين، وتحدَّث فيه المؤلِّفُ بإسهابٍ عن قياسِ التَّمثيلِ، وقياسِ الشُّمولِ، والاستقراءِ عندَ المناطِقةِ والفلاسِفةِ.
والفصلُ الثَّالِثُ: مخصَّصٌ للحديثِ عن القياسِ في المباحِثِ الإيمانيَّةِ الغيبيَّةِ عندَ المُتكَلِّمين، على اعتبارِ أنَّه من الأسبابِ التي أوقعت طوائِفَ منهم في الضَّلالِ البعيدِ.
والفصلُ الرَّابعُ: أورد فيه المؤلِّفُ عدَّةَ أوجُهٍ ممَّا وقع فيه المُتكَلِّمون من تهافُتٍ وتناقُضٍ في منهَجِهم العقليِّ، تدُلُّ على فسادِ هذا المنهَجِ، ومن ذلك وقوعُهم في الدَّورِ، وذلك بأن يَذكُرَ المُتكَلِّمُ مُقدِّمةً ثمَّ يبني عليها نتيجةً، وفي موضِعٍ آخرَ يذكُرُ تلك النَّتيجةَ كمُقدِّمةٍ، ثمَّ يستنتِجُ منها المقَدِّمةَ الأولى، تكونُ كُلُّ مُقدِّمةٍ منها مُثْبَتَةً بالأُخرى!
والفَصلُ الخامِسُ: في العَلاقةِ بينَ الفلاسفةِ والمُتكَلِّمين، بيَّن فيه المؤلِّفُ بإسهابٍ أنَّ أصولَ مذهَبِ المُتكَلِّمين من المعتَزِلةِ والأشاعِرةِ ليست من ابتداعِهم، وإنَّما كانوا فيها عالةً على الفلاسِفةِ والمناطِقةِ اليونانيِّينَ وغيرِهم؛ فقواعِدُهم مُقتَبَسةٌ منهم، بل حتَّى الأدلَّةُ التي استعملها المُتكَلِّمون كانت مأخوذةً منهم، مع اختلافٍ في التَّفاصيلِ والفُروعِ، ومع ذلك سمَّوا تلك المباحِثَ المقتَبَسةَ أصولَ الدِّينِ! وقد بيَّن المؤلِّفُ أمثلةً من نظريَّاتِ الفلاسفةِ، كأَرِسطو وأفلوطينَ، وتأثُّرَ المُتكَلِّمين بها.
ثمَّ ختَم المؤلِّفُ كتابَه بأنَّ ما يُسمَّى بعلمِ الكلامِ في مجمَلِه وأكثَرِ صُوَرِه وأمثِلتِه لم يكُنْ حاضرًا للدِّفاعِ عن عقائِدِ الدِّينِ في وَجهِ الكُفَّارِ، بل للدِّفاعِ عن عقائِدِ المُتكَلِّمةِ بعضِهم في وَجهِ بعضٍ، فمَن يتأمَّلْ كُتُبَ المُتكَلِّمةِ يَجِدْ أنَّ الفِرَقَ الإسلاميَّةَ الأخرى ورُدودَ بعضِهم على بعضِ أضعافُ رُدودِهم على الفلاسفةِ والملاحِدةِ والدَّهريَّةِ وأهلِ الدِّياناتِ الأخرى.